- ٢٣ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٥ | ٢٣ رجب ١٤٤٦ هـ
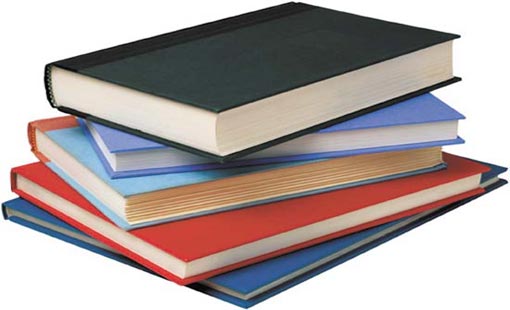
من الواضح أنّه لا يوجد أديب عربي واحد التزم منهجاً إسلامياً محدداً فيما ينتج من أدب القصة أو المسرحية أو الشعر. وإن كان لبعض أدبائنا جزء من أدبهم صدر عن شعور إسلامي، غير أنّ إقبال شاعر الإسلام وفيلسوفه الكبير وصاحب فكرة إنشاء دولة باكستان الإسلامية، هو أوّل أديب مسلم في العصر الحديث استطاع أن يستلهم الإسلام في وضع فلسفته المشهورة "فلسفة الذات" أو "خودي"، وكان شعره وعاء لهذه الفلسفة التي آمن بها، ودعا إليها في صدق وحرارة، ولم يحظَ شاعر أو فيلسوف مسلم بشهرة تضارع شهرة شاعرنا الكبير في هذا العصر، وقد أفردنا لهذا الشعر كتاباً صدر منذ سنوات بعنوان (إقبال.. الشاعر الثائر)، تحدّثنا فيه عن شعره وفلسفته ومنهجه الفني. ومن الواجب أن يحظى إقبال بمزيد من الدراسة، وأن تحظى فلسفته بمزيد من الشيوع والفهم، وهذا أمر بديهي بالنسبة لقمة من قمم الفكر الإسلامي.
نقول إنّ أدباء العربية ليس فيهم أديب واحد نستطيع أن نعتبره ممثلاً لاتجاه الإسلامية في الأدب في معظم إنتاجه، فمثلاً شوقي أمير الشعراء له عديد من القصائد في المناسبات الإسلامية المختلفة كالهجرة والمولد النبويّ، وله نهج البردة الشهيرة، وهمزيته الرائعة، وله بعض القصائد التي تترجم عن حياتنا الاجتماعية والسياسية ومشاكلها، وهذه بدورها لا تخرج عن صبغتها الإسلامية، لأنّ مشاكل المجتمع وأحداثه الكفاحية جزء من العقيدة الشاملة المسيطرة - أو المفروض أن تكون مسيطرة - على حياتنا في شعبها المختلفة. وقد أفرد بعض مؤرخي الأدب مؤلفات عدّة عن شوقي، منها (شوقي وشعره الإسلامي)، ومنها (الدين والأخلاق في شعر شوقي).
وكان شوقي (رحمه الله) ينظر إلى أيام الإسلام الأولى نظرة احترام وتقدير بالغين، وينظر إلى مبادئه العالية نظرة المؤمن بها، الواثق فيها كلّ الوثوق، ويترنم بأروع الشعر إذا ما تناولها، ويدعو الناس إلى التمسك بأهدابها، والنهج على سننها، وفي قصائده الأخرى كان ينتزع تشبيهاته عن السيرة الإسلامية، ويتخذ من أبطالها نماذج للقدوة، لكن شوقي لم يكن كإقبال، فإقبال فيلسوف قبل أن يكون شاعراً، ولفلسفته سمات وملامح وشخصية مميزة، عبّر عنها شعراً ونثراً، ولم يخرج عنها، وشوقي شاعر وليس فيلسوفاً، وشعوره الإسلامي شعور رجل مسلم دارس لأمجاد الإسلام وتراثه، معجب ببطولته وأيّامه الخالدة، ومبادئه السامية إعجاب شاعر، وفي اعتقادي أنّ شوقي كان أعظم شعراء عصره تحدثاً بأمجاد الإسلام ومبادئه، ولم يكن ينقصه غير التخطيط الفكري، أو البناء الفلسفي الذي يصدر عنه كما فعل شاعرنا الكبير محمّد إقبال.
وقد لوحظ أنّ موضوعات شوقي الإسلامية، تقترب من الموضوعات التي أثارها غيره من الكُتّاب، فقد انبرى طائفة للرد على اتهامات المستشرقين، وترهات المتحللين، فنجد في شعره - كما في كتابات محمّد حسين هيكل، والعقاد، وغيرهما - تعرّضاً لمشكلة الحرب في الإسلام، وهل الإسلام دين سيف؟ وهل إسراء الرسول كان بالروح أم بالجسد؟ إلخ.
يقول شوقي:
الحرب في حقّ لديك شريعة ***** ومن السموم الناقعات دواءُ
ويقول في موضع آخر:
يتساءلون وأنت أشرف مرسل ***** بالروح أم بالهيكل الإسراء؟
ويظل شوقي يجيب على هذه الأسئلة المعروفة، متخذاً من شعره منبراً لإعلاء كلمة الإسلام، مدافعاً عنه، مفسِّراً لأحداثها، في تعبير شعري رقيق خالٍ من تعمّق الفلسفة ومنهجها.
يقول عن الرسول (ص):
وكان بيانه للهدي سبلا ***** وكانت خيله للحقّ غابا
وعلَّمنا بناء المجد حتى ***** أخذنا إمرة الأرض اغتصابا
وما نيل المطالب بالتمني ***** ولكن تؤخذ الدنيا غلابا
وما استعصى على قوم منال ***** إذا الإقدام كان لهم ركابا
ولم تكن هذه الأشعار - في المقطوعة السابقة مثلاً - مجرد مديح في الرسول وتغنٍ بمبادئه وأثره الخالد في حياة البشر، بل كان ينتهز فرصة مديحه (ص)، ويحاول أن يوقظ شعبه النائم الرازح تحت نير العبودية والاستعمار، رابطاً المفاهيم الدينية بقضايا النضال واليقظة والتحرر، باثاً فيهم معاني القوّة والثورة والطموح في قلوبهم، بل كان يربط هذه المعاني الإسلامية بالقضايا الاجتماعية في وقت مبكر.
أما تراه يقول عن الرسول (ص) في همزيته الرائعة:
الاشتراكيون أنت إمامهم ***** لولا دعاوى القوم والغلواءُ
ويقول:
أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى ***** فالكلّ في حقّ الحياة سواءُ
ويقول:
الله فوق الخلق فيها وحده ***** والناس تحت لوائها أكفاءُ
ولقد وفق شوقي أيّما توفيق وهو يتغنّى بهذه الفضائل، ويستلهم المبادئ الإسلامية ويجلوها، وهو يشارك بقلمه في قضايا شعبه السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما كانت دعوته إلى الوحدة بين الشعوب العربية والإسلامية دعوة صادقة مخلصة، نبعت أوّلاً عن إيمانه بالخلافة العثمانية ودفاعه عنها في بادئ الأمر.. ولمّا انهارت الخلافة، لم يتخلَ عن الدعوة إلى هذه الوحدة، فإذا حرَّكه في بداية الأمر غرض سياسي، فقد دفعه إليها في نهاية المطاف شعور إسلامي واعٍ.
ورغم ارتباط شوقي بالقصر الذي تربّى فيه، إلّا أنّ الرجل - والحقّ يقال - لم يغفل جانب القضية الكبرى، قضية الشعب الذي يسعى إلى التحرّر الداخلي والخارجي، فنراه ينعي على الطغيان، ويمجد الدستور والحرّية والنظام الشوري:
زمان الفرد يا فرعون ولّى ***** ودالت دولة المتجبرينا
وأصبحت الرُّعاة بكلّ أرضٍ ***** على حكم الرعية نازلينا
فوأد أجل بالدستور دنيا ***** وأشرف منك بالإسلام دينا
ويقول في مكان آخر:
والدين يسر، والخلافة بيعة ***** والأمر شورى والحقوق قضاءُ
أجل.. إنّ مكانة شعر شوقي الإسلامي مكانة سامقة في عالم الأدب العربي، هذا إلى جانب إدخاله الشعر التمثيلي لأوّل مرّة في تاريخنا الأدبي، ومهما قيل عن ارتباطه بالقصر وإخلاصه له، فإنّ هذا لن يغض من روائعه الإسلامية، وقريحته اللماحة، وغيرته الفائقة على هذا الدين ومستقبله ومستقبل أبنائه.
أمّا أحمد محرم، فقد حاول أن يقدم ملحمة إسلامية، تتحدّث عن معارك الإسلام الكبرى، وأحداثه التي غيّرت مجرى التاريخ، وتغنّى في حرارة وصدق بالمُثل الإسلامية، والفضائل العظيمة التي تبرز في كلّ سطر من سطور كتاب الإسلام الضخم، ولعلّه كان أكثر شعرائنا المحدثين انكباباً على هذا الموضوع، وتحمساً له وتفانياً فيه، وإن كان دونهم في مجال الإبداع الفني.
أمّا مصطفى صادق الرافعي، فقد كان مجيئه ظاهرة أدبية ملفتة للنظر، لقد كان ظهوره إبان النهضة الأدبية الكبرى التي تزعّمها طه حسين والعقاد والمازني وشكري وهيكل ومطران وشوقي وحافظ ولطفي السيِّد وغيرهم، كان تيار التجديد دفاقاً مندفعاً، وكانت هناك دعوات غريبة للغض من القيم الدينية، والتراث العربي الأصيل، وتحريض للمثقفين على الاندفاع نحو الغرب والنهل من ثقافته، والنسج على منواله دون تحفّظ أو تبصّر، هذا من جانب.
ومن جانب آخر، برز الرافعي متحدياً صارخاً في وجه الاندفاع الأعمى نحو كلّ ما هو غربي، لقد مثّل الرافعي دوراً كان لابدّ أن يمثّله، دافع عن القديم، وثار من أجل اللغة والدين والقيم العريقة، واستمسك بأسلوب العربية الفصحى وإن أغرب في اللفظ، أو بدا التعقيد في بعض تعبيراته. لم يكن غريباً أن يتطرّف الرافعي وهو يرى طائفة من المفكِّرين يدعون إلى اعتبار العامية لغة للكتابة، وطائفة أخرى تدعو إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية، وثالثة تأخذ على الدين جمود رجاله، وتوقف نمو فقهه وأحكامه، لقد اعتبرها الرافعي معركة مقدسة، واعتبر أدنى تفريط فيها جناية كبرى، ومن ثمّ حميت المعركة بينه وبين غيره من النقّاد أمثال طه حسين والعقاد.
وعلى الرغم من كلّ ما يقال في حقّ الرافعي، وفي أسلوبه المعقّد، وفي آرائه الغريبة، إلّا أنّه ممّا لا شك فيه قد أدّى دوراً كبيراً يتفق مع معتقداته وثقافته وظروف عصره. ففي مقالاته التي كتبها في (وحي القلم)، تظهر براعته الفنية ككاتب قدير. فكتابه (وحي القلم) بالذات واضح مفهوم، وموضوعاته التي عالجها فيه محددة بينة المقاصد، وهي تجمع بين القصص الهادفة، والمقالات الاجتماعية والسياسية العميقة، والدراسات النقدية والإسلامية المفيدة. وعلى الرغم من أنّ قصصه لم تتبع المفهوم الحديث لفن القصة تماماً، إلّا أنّها ذات دلالة توحي بأنّ الرجل لم يكن منعزلاً عن عصره، بعيداً عن أحداث المجتمع كما يزعم البعض، بل انفعل بكلّ القضايا والحركات الفكرية المعاصرة، وليس أدل على ذلك من تلك المعارك الحامية الوطيس التي نشبت بينه وبين معاصريه، وتلك الصُّحف والمجلات التي فتحت له صدرها، وهؤلاء التلامذة العديدون الذين آزروه، وتتلمّذوا عليه، وآمنوا بطريقته.
وفي اعتقادي أنّ كتاب (وحي القلم) بأجزائه كلّها تعبير صادق عن وجهة نظرنا، ولقد كان الرجل محافظاً على القيم الأخلاقية والعقيدية فيما يكتب، ولعلّ محافظته وتشبثه بهذه القيم هو الذي دعا مخالفيه في الرأي لأن يرموه بالجمود والرجعية. وربّما كان كتابه (المساكين) أقل وضوحاً من (وحي القلم)، لكنّه لم يخرج عن خطته الأخلاقية ومنهجه الفني. لكن الغموض يبدو أكثر في كتابه (أوراق الورد) و(حديث القمر) و(السحاب الأحمر)، وهي تعالج موضوعات عاطفية، وتتعمّق في النفس والوجدان، وتصوّر خلجات الأعماق، ونزعاتها وانتفاضتها الهامسة الغامضة. ورغم غموضها بعض الشيء، إلّا أنّ هذه الكُتُب الثلاثة لم يسبقها شبيه لها في أدبنا العربي على ما أعرف، وأظن أنّ الرافعي أوّل أديب عربي استطاع أن يفلسف الحبّ وما يخالطه من مشاعر ويغوص إلى أعماق النفس، ويحلل فورانها بطريقة لم يسبقه بها أحد. كان واحداً بلا شك بين رواد النفس الإنسانية في أدبنا العربي وما أقلهم.. ولن يعيبه غموضه فسوف تكفيه أصالته وذكاؤه وغوصه في أعماق الإنسان، وذلك العالم الكبير العصي على الفهم والإدراك. أمّا كتاباته في إعجاز القرآن أو تحت راية القرآن، فقد كانت محاولة جادة وأصيلة في إبراز القيم الفنية والأدبية لكتاب الله.. لا تنقصها الحرارة التي عرف بها الرافعي، ولا الغيرة الدينية التي لم تخفت حدتها طول حياته.
ولشعره رقة وعمق.. لم يكن جافاً بارداً كما زعم خصومه، ولم يخل من المضمون الأصيل كما ادّعوا، وتحضرني هذه الأبيات التي يصوّر فيها حبّاً حزيناً دامعاً، فيخفق لها قلبي، وأشعر معه بالأسى واللوعة:
مَن للمحب ومَن يعينه ***** والحبّ أهنؤه حزينه
أنا ما عرفت سوى قساوته ***** فقولوا كيف لينه؟
إنّ الرافعي لم يزل في حاجة إلى الدراسة والبحث، وتراثه الأدبي لم يزل في حاجة إلى تقييم حقيقي، ومكانته الأدبية، ونبل المشاعر التي حرّكته، وعنف المعارك التي خاضها لابدّ أن تفهم كما يجب.
وكان لأدب توفيق الحكيم نكهة حلوة، فيه سحر الشرق وجلاله، وفيه جمال الروح وأشواقها، فيه انتصار للقوى الروحية وتشبث بها، واهتمام بالمشاكل المجردة كالخير والشر والقضاء والقدر، ولقد انتزع الحكيم كثيراً من مادّته الأدبية من التاريخ والأساطير مثل مسرحية (أهل الكهف) و(سليمان الحكيم) و(شهرزاد) و(بيجماليون) و(براسكا) و(أوديب ملكاً)... وغيرها.
وعلى الرغم من أنّ الحكيم انتصر للقوى الروحية ولم ينكر عالم ما وراء الطبيعة، إلّا أنّه كان فناناً يضع نصب عينيه قداسة الفن وأُصوله، قبل كلّ شيء، غلب فنه على ما سواه وإن تشبّع بفلسفة الشرق وارتوى من مناهله الروحية، وبهذا كان أخلص الفنانين المؤمنين بالقوى الروحية فناً وأداءً. وكانت مسرحيته (محمّد) لحناً رطباً يفيض رقة وسلاسة ويمتلئ بالصور الحيّة المتحركة في حياة الرسول (ص)، وبالسلوك الإلهي الرائع، ولا يعنينا هنا أن نتكلّم عن تكنيكها ومدى مطابقتها للقواعد المسرحية، لأنّ ما نهتم به في هذا العرض السريع يتصل بالمضمون أكثر ممّا يتصل بالشكل.
وفي كتاباته الأخرى (عودة الروح) و(الرباط المقدس) و(يوميات نائب في الأرياف) و(الصفقة) و(مدرسة المغفلين)، يعالج الحكيم عدداً من قضايانا الاجتماعية المعاصرة، في ضوء فلسفته التي أفرد لها كتاباً، وهي فلسفة (التعادلية)، وفي ضوء آرائه في (الفن والأدب).
وقد ألمحنا من قبل إلى مسرحيته الأخيرة (السلطان الحائر)، وكيف أنّه استمدّ أحداثها من التاريخ الإسلامي، واتخذه مادّة لتصوير الصراع الخالد بين السيف والقانون، ووقف ببطل المسرحية عندما أسماه بعض نقادنا موقف "الاختيار الوجودي"، إذ يشعر السلطان بالحيرة وهو في حالة يستطيع معها أن يحكم السيف ويسخر من القانون، أو ينتصر للقانون، وينحي السيف بعيداً، لأنّ الحقّ فوق القوّة، ولأنّ الحقّ منطق، ويتجلّى تأثر الحكيم بالقيم الإسلامية حينما يجعل أساس المشكلة فتوى لقاضٍ من العلماء المسلمين، تتهم الحاكم بأنّه ليس حرّاً، والعبد لا تحق له طاعة إلّا إذا اعتق..
ورغم ما أصاب تصوير شخصية القاضي من بعض الاضطراب والتخلي عن جزء من القضية التي وضع رقبته تحت رحمة السيف من أجلها، إلّا أنّ مسرحية السلطان الحائر مثلاً رائعاً لما نُسمِّيه بالأدب الإسلامي، وما نُسمِّيه بـ"الاختيار الإسلامي" وليس "الاختيار الوجودي" كما زعم بعض النقّاد، فمادّة القصة وفكرتها وشخصياتها ومضامينها الفكرية كلّها واقع إسلامي مستمد من التاريخ، ونهايتها انتصار للمثل والمبادئ على القوى المادّية الغاشمة، وكم كنّا نود أن نستطرد في شرح المسرحية وتحليلها على هدى هذه المفاهيم لولا ضيق المقام.
وخلاصة القول: نقول إنّ الحكيم أديب شرقي مسلم متحرر متطرف في تحرره، لم يستطع أن يقرر في صراحة وضوح إيمانه بمبدأ الالتزام إطلاقاً، وإن التزم في كثير من المواضع بفلسفته "التعادلية" التي شرحها وفصل بناءها في كتابه.
والحكيم إلى جانب ذلك رائد من رواد المسرح العربي، وأحد رجال الطليعة في القصة العربية ومفخرة من مفاخر أدبنا العربي الحديث، والحكيم فنان تظهر فيه ملامح الشرق وروحانيته، لا ملامح الإسلام وحدها إلّا في أحيان قليلة.
أمّا عليّ باكثير مؤلف (وا إسلاماه)، فقد بدأ حياته دارساً للإسلام والفقه والحديث والتاريخ، أراد أن يكون عالماً مجتهداً من علماء الإسلام، وشاء الله أن يصبح أديباً من أدبائه، واستطاع باكثير أن يُصوِّر بعض صفحات التاريخ الإسلامي الخالد، ويُعبِّر عن نماذجه الفذة في قصته (وا إسلاماه)، حينما تعرّض الإسلام للغزو الصليبي والتتري.
وللأستاذ باكثير مسرحيات (دار ابن لقمان) عن الحروب الصليبية، و(إله إسرائيل) عن المشكلة اليهودية، و(الحاكم بأمر الله) و(جحا) و(شهرزاد) و(أوديب)، وله من القصص: (سيرة شجاع) على قرار (وا إسلاماه)، وله من المسرحيات الاجتماعية (الدنيا فوضى)... إلخ.
وكانت أغلب كتاباته مستمدة من التاريخ أو الأساطير القديمة، ومشى على نهج الحكيم في التفاته إلى بعض المشاكل الفلسفية المجردة، وإن لم يستطع اللحاق به في التفوق الفني الذي جعل الحكيم واحداً من كبار كُتّاب أدبنا ورواده، ولكن كان باكثير أكثر ارتباطاً واستمساكاً بالمبادئ الإسلامية ووجهة نظرها في الحياة، ومن ثمّ فإنّ أدبه جدير بدراسة عميقة وبتحديد صادق لقيمته الفنية والعقيدية.
هذه الجولة السريعة في الأدب الإسلامي الحديث، لم تستطع أن تستوعب كلّ ما ظهر منه، ولم تتناول كل كُتّابه، وخاصّة أدباء الجيل الجديد، فالمجال هنا أضيق من أن يقوم بإحصائية شاملة لأدبنا الإسلامي الحديث، لكن ما قدّمناه مجرد أمثلة موجزة، وتعليقات سريعة، وأحكام عامّة تحتاج لمزيد من العناية والدرس العميق المنظم، وأرجو أن تتاح فرصتها لي أو لغيري للقيام بها خدمة للفن والدين.
ولا يفوتني في هذا المقام أن أشير إلى تلك الألوان الفنية الرائعة التي قدّمها الدكتور طه حسين في كتبه: (على هامش السيرة) و(الوعد الحقّ) وغيرهما، وكانت هذه الألوان المميزة مزيجاً من الأدب والتاريخ، ليست بالقصّة ولا بالمقالة ولا بالدراسة التاريخية على وجه الدقة، وإن اقتربت من هذه، أو اقتربت من تلك في بعض مواضعها، لكنّها مع ذلك لون أدبي، ناصع البياض، مشرق اللمحات، واضح الأصالة.. ولابدّ من الإشارة أيضاً إلى إسهامه في تحديد بعض القيم النقدية في الأدب الحديث، وترجمة بعض الآثار العالمية إليه، والدعوة إلى التجديد وإحياء التراث، وإعادة النظر فيه والتطوّر به إلى مرحلة أنضج وأروع.
المصدر: كتاب الإسلامية والمذاهب الأدبية
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق