- ٢٣ كانون ثاني/يناير ٢٠٢٥ | ٢٣ رجب ١٤٤٦ هـ
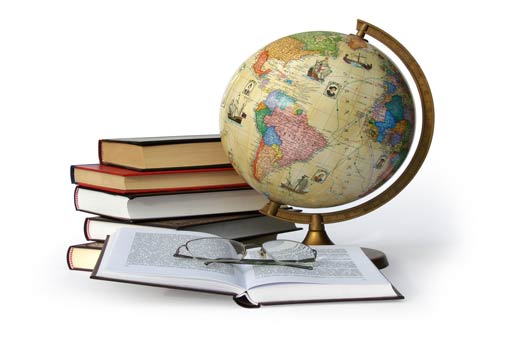
ارتبطت الثقافة الإسلامية بأصول روحية تجعل من الممكن حصر مضمونها، لكنها ارتبطت في نفس الوقت بتاريخ وبجغرافية مما جعلها تجتاز بأشكال من الاتصال والتلوين والاختمار. فالثقافة الإسلامية هي التي أوجدت الجدل وعلم الكلام والفلسفة الإسلامية والتصوف وكلها إفرازات نشأت عن الأطوار التي مر منها المجتمع الإسلامي في تجربته الطويلة التي ارتبطت بوثبة تاريخية كبيرة وحضارة غنية ما زالت في مسيس الحاجة إلى الدرس والاستكشاف.
ونشأ عن ذلك تصوران للثقافة الإسلامية:
1 ـ تصور أساسي يرجع بنا إلى المصادر الأولى التي أسست الإسلام والتي لا يتجادل في صحتها أي مسلم، ونعني بها الكتاب والسنة.
2 ـ تصور تاريخي يربط بالثقافة الإسلامية كل ما أنتجه المجتمع الإسلامي، عبر تاريخه الطويل، في ميدان العلوم والآداب والتقنيات والفنون، إلخ.
ويترتب عن الجمع بين التصورين أشكال من الخلط والالتباس يتعثر بينها الباحثون ويتضرر منها البحث. وبديهي أنّ السبب يكمن في الإزدواجية التي نربطها بمعنى النسبة حينما نقول إسلامي. ففي صورة أولى تعني تلك النسبة علاقة بالجوهر، جوهر الإسلام أي بتعاليم الإسلام وروحه. مثال ذلك الزواج الإسلامي أو الإرث الإسلامي. فالأول يعني زواجاً يجري حسب مقتضيات الشرع الإسلامي، والثاني يعني، أيضاً، التقيد بالقواعد التي أقرها الإسلام فيما يخص الميراث طبقاً لما ورد في الكتاب والسنة. فنسبة الزواج والميراث نسبة الفرع إلى الأصل، أو هي نسبة عضوية لأنّها تدخل في إطار تصور عام للإسلام.
وبخلاف ذلك قولنا الخزف الإسلامي أو الهندسة المعمارية الإسلامية. فما هو الرابط بين الخزف والإسلام في المثال الأول؟ إنّه الرابط الجغرافي، إذ يعني الخزف الذي صنع في بلاد الإسلام ولو كان صانعوه من غير المسلمين، ولو كان مقتبساً عن نماذج وجدت قبل الإسلام أو في بلاد غير إسلامية. فنستطيع أن نقول الخزف الإسلامي ونحن نتحدث عن بعض المخلفات الأثرية التي وجدت بفارس والعراق منذ القرن الأول والتي تمثل استمراراً للتقاليد الصناعية التي وجدت في البلدين قبل الإسلام. وبالفعل، توجد أنواع من الخزفيات في كل البلاد الإسلامية، يمكن ربطها بالتراث الحضاري السابق للإسلام، على الأقل من بعض الجوانب. ومن الممكن أن يكون انضافت إليها بعض التحسينات في عهد الإسلام، إلا أنّ التحول الطارئ يبقى ذا صبغة تقنية وفنية، وليست له علاقة جوهرية بالإسلام، بل العلاقة عرضية كما يقول الفلاسفة. فنحن حينما نقول الخزف الإسلامي نعني به، في آن واحد، الخزف الذي وجد في الهند الإسلامية أو في آسيا الوسطى أو بفارس أو في العراق أو في المغرب أو في الأندلس على اختلاف أشكاله وألوانه وجودته، وإذا قلنا إنّ النسبة عرضية فنعني بذلك أنّها تاريخية لأنّ التاريخ يعني، في أساسه، احتكاك الجواهر بالأعراض.
فإذا انتقلنا إلى الهندسة المعمارية، ننتهي إلى نفس الملاحظات. فالإسلام لم يحث المسلمين على لون خاص في الهندسة، بل ترك لهم كامل الحرية في هذا الشأن. لكن، كثيراً ما نصادف عبارة (الهندسة المعمارية الإسلامية) في كتب التاريخ. وهي لا تعني أي تناقض. وإنما تعني اختيارات فنية سار فيها المسلمون منذ نشأة حضارتهم واستحكمت مع طول الزمان. وهذه الاختيارات ليس لها ارتباط بالإسلام بقدر ما لها من ارتباط بذوق المسلمين وميولهم كبشر.
فالبيت الإسلامي، مثلاً، من الكوخ المتواضع إلى القصر الشامخ لا يوجد أي توجيه في شأنه بالنسبة للنصوص الإسلامية الأساسية ولهذا فهو يختلف من الشرق إلى الغرب، من حيث التصميم والزخرفة والهندسة ويتنوع تبعاً للمناخ ولطبيعة البلاد. ورغم التنوع والاختلاف سمي إسلامياً لأنّ المسلمين سكنوه، لا لأنّه يرتبط جوهرياً بالإسلام. وكذلك الشأن في المسجد الذي ليس مفروضاً فيه إلا احترام وجهة القبلة، باعتبار التعاليم الإسلامية. فالمحراب الذي يقف فيه الإمام ويصلي الناس خلفه، يجب أن يكون مواجهاً للقبلة. وفيما عدا هذا الشرط البسيط ليس هناك أي تقييد فيما يخص هندسة المسجد، بحيث تبقى كامل الحرية للمهندس وصاحب الزخرفة والبناء في إنجاز عملهم حسبما توحي به لهم قريحتهم الفنية.
والملاحظ في تاريخ الفن الإسلامي أنّ أصحاب المعمار لم يستثمروا حريتهم، فيبتكروا أشكالاً وأساليب مختلفة، بل ظلوا في الغالب، أولياء للنماذج الأولى، النماذج الكلاسيكية، مما جعل عامة المسلمين يضفون على تلك النماذج صبغة القداسة، ويعتقدون أن الخروج عنها فيه نوع من البدعة. وهذا ليس بصحيح. فإذا رأوا مهندساً أو فناناً يخرج عن المألوف ويحاول أن يبتكر ويجدد، قابلوا عمله بنوع من التحفظ. والجمود الذي عانى منه الفن الإسلامي، في عصور الانحطاط، بالخصوص، يرجع إلى هذه الموقف وهاته العقلية. وفي عصرنا هذا رأينا أساليب هندسية عصرية تستعمل في إعادة بناء بيت الله الحرام بمكة والمسجد النبوي بالمدينة، فقوبل ذلك بالاستحسان ولم يثر المشروع الجريء الذي غير المعالم السابقة رأساً على عقب أي احتجاج، ولم ينسبه أي عالم للبدعة لسبب بسيط وهو أنّه ليس هنالك أي ارتباط عضوي بين أي شكل من أشكال الهندسة المعمارية والإسلام. بل إنّ الإسلام يرحب بها جميعاً، ويعتبرها من الشؤون الدنيوية التي ترجع لأرباب الفن والخبرة.
وبالجملة، فمثال الهندسة المعمارية الإسلامية يبين لنا، بكل وضوح، المراد من النسبة الإسلامية. فهي نسبة لا تتصل بالجوهر، وإنما هي نسبة تاريخية تحكمت فيها ظروف وأحداث. فالصورة التي تبرز لنا بها تلك الهندسة ليس لها صبغة حتمية، بل كان من الممكن أن تبرز على أشكال أخرى، دون أن نجد في ذلك أي تناقض أو نشاز.
معنى ذلك أنّنا إذا أردنا أن نعرف الثقافة الإسلامية، أو بالأحرى قواعد الثقافة الإسلامية، يجب أن نعود إلى التصور الأول، التصور الأساسي، الذي يحصرها في تراث محدود ومعروف، الكتاب والسنة. والموضوع الذي نعرض له الآن ليس جديداً. فقد أثير منذ بداية الخوض في العقيدة الإسلامية والشروع في وضع العلوم الإسلامية. فقد اختلفت الآراء في عدد من القضايا وظهرت فرق وقام جدال في المجتمع الإسلامي، ابتداء من القرن الأول للهجرة. وكان للفكر اليوناني والفارسي والهندي ولمذاهب الغنوصية تأثيرها في النقاش القائم، مما جعل عدداً من العلماء المسلمين يبحثون عن المعايير التي تمكنهم من التمييز بين ما هو إسلامي وما هو غير إسلامي، فانتهوا إلى المبدأ الذي يجعل الارتباط بالأصول هو المعيار الذي لا يقبل الجدال. فكان أصحاب هذا الموقف هم مؤسسي مذهب السنة والجماعة. فالمناهج الذي اتخذوه هو الذي يجيب، بالضبط، على السؤال المطروح: ما هي أصول الثقافة الإسلامية؟ ويكفي أن نأخذ فكرة عن المجهود الذي بذلوه ليتضح لنا الاتجاه الذي ساروا فيه.
فهم، حينما عرضوا لتفسير القرآن، حاولوا جهد المستطاع أن يكتشفوا ما أثر عن النبي (ص) وعن صحابته من أقوال وتوضيحات عن مختلف الآيات القرآنية، وظلوا على العموم، مسايرين للنصوص، في معانيها اللغوية، فلم يميزوا بين ظاهر وباطن كما فعلت مذاهب أخرى ولم يغرقوا في التأويل، وربطوا بين الآيات وأسباب نزولها. ويعتبر تفسير الطبري (جامع البيان) خلاصة لهذا المجهود العلمي الضخم. وفيما يخص جمع السنة النبوية اتخذوا منهاجاً نقدياً مدققاً وصارماً مبنياً على غربلة الروايات المختلفة ما بين شفوية ومكتوبة وترتيبها حسب درجتها في الصحة. فظهرت كتب الحديث المشهورة وكتب السيرة والطبقات المبنية على التحقيق والتوثيق. وتظافرت الجهود في هذا الشأن وساهم العديد من العلماء في الميدان مما جعل الحصيلة تقدم، في النهاية، أكثر ما يمكن من الضمانات. بحيث يجد الباحث، اليوم، أمامه مجموعة من النصوص التي وقع الإجماع على صحتها، فتكون إلى جانب القرآن الكريم الأساس الذي يستند إليه الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية.
فإذا أردنا أن نعرف اتجاه الإسلام في الميدان الفكري والثقافي، يجب علينا أن نقف عند هذه الأصول ونعيد قراءتها بكل تركيز وتعمق، ونخلصها من كل ما لصق بها أو خالطها من عناصر دخيلة. وإذا كان هذا الاحتياط ضرورياً في كل عصر وآن، فإنّه أشد ضرورة في وقتنا هذا، قد طغت عادة التأويل، وتحكم الاختيار الإيديولوجي في توجيه الأفهام. فهنالك مَن يرى في الإسلام أساس الديمقراطية الحديثة، وهنالك مَن يرى فيه جانب السلطة القوية، وهنالك مَن يكتشف فيه دعوة اشتراكية إلخ. وقبل الوصول إلى استنتاجات وأحكام من هذا النوع، يجب التعرف على الإسلام من خلال نصوصه.
فمن دون شك أنّنا سنكتشف للإسلام وجهاً خاصاً به، يميزه عن كل المذاهب والإيديولوجيات العصرية، سيما إذا اعتبرنا أنّ هذه الأخيرة تضع نفسها في حدود العالم المحسوس وفي إطار الفعالية داخل الدائرة التي يستطيع العقل البشري أن يتحكم فيها، في حين أنّ الإسلام يتميز بشمولية تجمع بين عالم المحسوس وما وراء الطبيعة، بين الشهادة والغيب، وتطلب من المؤمن أن يضعهما كليهما في نفس الاعتبار وأن يعمل للثاني عما يعمل للأول: (اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً، واعمل لآخرتك كأنك تموت غداً). فهو لا ينفي طاقة العقل البشري، ويعتمد عليها كقوة تساعد الإنسان على الإدراك والتصور والاستدلال، كما تشهد على ذلك الآيات القرآنية، لكنه لا يعتبرها طاقة مطلقة لا حدود لها، لأنّ العقل البشري يقف في مستوى معين لا يتجاوزه (وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلا قَلِيلا) (الإسراء/85).
فالموازنة في ضمير الإنسان بين الدنيا والآخرة توحي إليه بسلوك متوازن، فلا يتكالب على الأولى بشرهٍ ونهم حتى يقع في مهاوي الأنانية والاحتكار والرأسمالية، ولا يقف نفسه على الثانية فينسى كل شيء ويتخلى عن الكد ويسقط في مساوئ الإهمال والحرمان، فهذه الموازنة بين الدنيا والآخرة تعطي للأخلاق دورها وللقيم وضوحها وللمبادئ رسوخها وقوتها فتلتقي مع فكرة (الأمة الوسط) التي نعت بها القرآن الكريم الأمة الإسلامية.
وموضوع من هذه الأهمية يستحيل معالجته في مقال قصير وإنما كان قصدي أنّ أبين أنّ الفكر الإسلامي له خصوصيته وطرافته التي يجب البحث عنها والمحافظة عليها، بعيداً عن كل تساهل في التشبيه والمقارنة، ويجب النظر إليه ككل، كنسق واحد، لا يمكن الفصل بين أجزائه دون المساس بروحه وغائيته.
وفي معالجة هذا الموضوع الأساسي، يمكننا أن نقول إنّ علماء السنة انقسموا إلى طائفتين:
1 ـ طائفة وقفت عند النصوص في ظاهرها فتتبعتها في منعرجاتها وتفاصيلها، مقتصدة في مجهود التركيب والتنسيق. وهذا ما نجده لدى عدد من المفسرين والمحدثين الذين يلقون هذه التبعية على عاتق القارئ المؤمن، وهذا هو موقف الأكثرية منهم.
2 ـ طائفة تعمقت أكثر في دراسة النصوص فحاولت أن تقدم عن الإسلام صورة متناسقة وشاملة رابطة بين الأصول والفروع والمبادئ والغايات في بناء واضح المعالم والقسمات. وهو ما نلمسه لدى بعض المفكرين الكبار مثل الغزالي وابن عربي وابن حزم وعدد من أقطاب الصوفية. فهؤلاء اهتموا بالكشف عن (روح) الإسلام أي حاولوا أن يتجاوزوا التعاليم الفرعية الخاصة بالعبادات والمعاملات إلى الكشف عن حكمة الإسلام ومقاصده. وهو ما جعلهم يتعرضون للانتقاد، بل والاستنكار.
لكن دور هؤلاء العلماء المفكرين في المحافظة على الإسلام والدفاع عنه وإبراز مزاياه مهم جداً ولا يمكن تقديره، لأنّهم يقربون الدين من مدارك الإنسان ومن شعوره ومن حياته اليومية بما فيها من نعيم وبؤس. وقد سُمّي الغزالي حجة الإسلام لأنه عرف كيف يربط بين الإسلام والعقل البشري بمنهاج يجمع بين الحدس والعقل ويرتكز على منطق واضح قوي في استدلاله. فالإنسان، حين يرتفع إلى مستوى من الإدراك والوعي، في حاجة إلى أسلوب الخطاب الفلسفي وهو ما التجأ إليه الغزالي، الذي له مكانه المتميز بين الفلاسفة المسلمين.
وعلى هذا النهج قامت السلفية في العصر الحديث على يد جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، لتقدم صورة مجددة عن مقاصد الدعوة الإسلامية وارتباطها بالحضارة والتقدم العلمي وتحرير الإنسان. فقد أعاد أصحاب هذه المدرسة قراءة القرآن والحديث، على ضوء التطورات التي دخلت على العالم المعاصر، واعتباراً للتدهور العام الذي أصاب المسلمين في مختلف أقطارهم. فخرجوا برؤية جديدة تختلف عن مواقف الجمود والتعصب التي سيطرت على علماء المسلمين في العصور المتأخرة، وأبرزوا أنّ الإسلام مع النهوض والتطور أي أنّه يرحب بكل المكاسب الإيجابية التي تمخضت عنها الحضارة الحديثة.
فالخدمة الكبيرة التي قدمتها المدرسة السلفية للمجتمعات الإسلامية هي أنّها جعلتها تحتضن التطور وتقتبس كثيراً من مظاهر التقدم عن الدول الأوربية التي هي غير مسلمة، دون أن تشعر بتناقض أو تحرج أو انحراف عن الإسلام. ولا نحتاج إلى التذكير بأنّ تيار العالمية والمعاصرة وتأثير العالم المتقدم على العالم المتخلف ما كانا ليتركا لأي دولة أن تعيش منزوية ومتجاهلة لما يجري حواليها.
لكن المشكلة التي تظل مطروحة بالنسبة للمجتمع الإسلامي تكمن في تقييم الاتجاه الذي يسير فيه ذلك التيار: هل يزكيه مسبقاً ويتبناه كمثل أعلى ويحاول ربطه بالتعاليم الإسلامية عن طريق التساهل في التأويل، كما يقع كثيراً؟ نحن نعلم أنّ التطور الذي سار فيه العالم المعاصر في كل الجهات المتقدمة يطرح عدة مشاكل اجتماعية ونفسية وأخلاقية. والمتتبعون لأخبار البلاد (المتقدمة) في أوربا وأمريكا يعرفون الأزمات التي تمر منها ويطلعون يومياً على ما يجري فيها من فضائح وجرائم شنيعة. وأكبر فلاسفتها ومفكريها المعاصرين حكموا عليها بالإفلاس.
صحيح أنّ الحضارة الحديثة حققت عدة مكاسب بالنسبة للإنسان على المستوى العلمي والمادي والسياسي. ولكن المثل الأعلى الذي تتجه إليه هو: مجتمع الاستهلاك أي المجتمع الذي يغري الإنسان بالتجاوب مع رغباته ومداعبة غرائزه وتخدير فكره بالرفاهية المصطنعة. فهو مجتمع يغالي في فكرة الاستمتاع والتنعم، فيبتعد حينئذ عن (التوسط) الذي دعا إليه الإسلام، ضامناً له تحرره من كل العبوديات البارزة والمقنعة، بحيث أنّ الاستهلاك ليس شراً في حد ذاته، إذا لم يتجاوز الحدود المعقولة فيسد أمام الإنسان مدارج الحياة الرفيعة، ويحجب عنه الآفاق البعيدة ويقيده في دوامة الرغبات والحاجات اليومية، جاعلاً منها جوهر الحياة وبذلك يغلقه في عبودية لا يشعر بوطأتها لأنّها تنطوي على نوع من التخدير.
وإذن، فالتعامل مع تيار العالمية والمعاصرة والتقدم لا يمكن أن يكون على أساس الاستسلام اللامشروط، إذا حاولنا أن نطبق الدعوة الإسلامية تطبيقاً صحيحاً. فالمشروع الذي أتى به الإسلام، دون أن يرفض أي مكسب إيجابي في الحضارة المعاصرة، يقدم في نفس الوقت ما يقوّم اعوجاجها ويعود بالإنسان إلى طريق التحرر من متاهات الأوهات والتخدير وما يكمن خلفها من عبوديات. إنّه مشروع مجتمع جديد ما زال المسلمون بعيدين عن إقامته، لأنّه يتطلب كثيراً من الدرس والتهيئ والتخطيط.
فهو، في خاتمة المطاف، مجهود يتجه للمزيد من استكشاف ينابيع الثقافة الإسلامية ومضامينها، على ضوء التجارب التي مرت منها الإنسانية والقضايا الجديدة التي طرحت على الإنسان في هذا العصر. مما يقتضي إعادة لقراءة القرآن ودراسة السنة. وهو الاستنتاج الذي ينتهي إليه عدد من المفكرين المسلمين المعاصرين، وكأنهم ينتهون إلى الاقتناع بأنّ المجهود الذي بذله الأجداد في هذا الصدد لم يعد كافياً ولا وافياً بحاجتنا الراهنة.
المصدر: مجلة الإسلام اليوم/العدد 3/1985م
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق