◄يستفيق وعي الإنسان بالقراءة والتدبر، ويمارس عقله الوظيفة الكبرى التي خُلِق لأجلها، وتميّز بها عن سائر المخلوقات الأخرى، بل أضحت له السيادة عليها، ومُنح الحق في تسخيرها والافادة منها في بناء حياته وتأمين متطلباتها المتنوعة. فالقراءة هي المصباح الذي يقوده لاستجلاء أسرار هذا العالم، واستكشاف النواميس والسُنن المتحكمة فيه، ثمّ التعرف على مبدئه ومصيره، وبالتالي تحديد مركزه في العالم، ووظيفته ازاء خالقه ومبدئه، وحدود حريته في كيفية استخدام المخلوقات واستثمارها في اشباع حاجاته. وتدل أول كلمة يهبط بها الوحي من السماء وهي الأمر (اقرأ) والتي أُردفت بعد آية واحدة بالأمر الآخر (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ) (العلق/ 3)، تدلّ دلالة واضحة بما لا يقبل الشك على انّ القراءة هي الأداة الضرورية لأية عملية بناء تُشاد في حياة الإنسان، فكما يتوقف إرساء الرؤية الكونية التوحيدية على استكناه الواقع والتعرف على شيء من أسراره، باعتباره أقرب السبل التي توصلنا إلى ترسيخ الاعتقاد بالله، كذلك تتوقف أية خطوة تتقدم بها حياة الإنسان إلى الأمام وتساهم في إرساء حضارته على القراءة وسبر قوانين الطبيعة وسُنن الحياة الاجتماعية.
وبوسعنا أن نستظهر جملة دلالات من (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ... اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ) (العلق/ 1 و3)، منها انّ القرآن وسمَ النبي الكريم (ص) وأمته بسمة تكريم تجعل هذه الأُمّة متفوقة على سواها من الأُمم إذا واظبت على قراءة وتدبّر القرآن، والطبيعة، والحياة البشرية، أي قراءة الوحي والواقع، بينما يتراجع موقعها ويتعرض مسارها لانكسارات لو أهملت القراءة، لأنها ستغفل عن لحظتها الراهنة، ويحتجب عنها المستقبل، فتظل ساكنة فيما العالم من حولها يتحرك. ومن الدلالات التي يحكيها الأمر بالقراءة، هي ان هذا التكرار السريع للأمر، واستهلال الوحي به، يؤرخ إلى منعطف حضاري عميق يؤذن ببداية عصر العلم والمعرفة ومضي عصر الجهل والأمية، وهو تعبير عن دخول الأمة التي ستقرأ وتتدبر ما تقرأ العصور الجديدة، التي تحمل فيها مشعل العلم إلى البشرية كافة، وتظل تواصل هذه المهمة سبعة قرون، فيما الأمم الأخرى – أوربا خاصة – ترزح في دياجي الجهل والخرافة، وما تفرضه الكنيسة من عقائد ومفاهيم وآراء تعسفية متخلّفة. غير انّ الدور الحضاري للأُمّة الإسلامية تراجع حالما انحسر اهتمامها بالقراءة والتدبر، فانطفأت في حياتها جذوة الإبداع، وعادت إلى ما بيدها من ميراث الاسلاف، تُكرر شرحه وتُفكر في مداراته.
- لماذا نقرأ؟
القراءة تعطي الإنسان الواحد أكثر من حياة، لأنها تضم إلى تجربته تجارب أشخاص آخرين، عاشوا نمطاً مغايراً لحياته، فسجلوا أساليب تعاطيهم مع وقائع الحياة، وتحدثوا عن مواطن فشلهم ونجاحهم، ونبهوا إلى أسرار خطيرة يلزم أن يفني الإنسان أحياناً حياته كلها لينتهي إلى تعلُّم الخبرة التي وقف عليها أولئك الناس في الماضي، بل إنّ القراءة تضم إلى تجربة الفرد تجارب أبعد مدى وأعمق من دائرة تجربة أفراد معدودين، ذلك إنّ القارئ بوسعه مواكبة المسار العام لحياة المجتمعات الغابرة عبر مطالعة عوامل نشأتها وتطورها ثمّ انحطاطها وذوبانها، ومثل هذه الرحلة نحو الماضي والاقتراب من حياة الناس وأحوالهم في عصر سحيق تموّن القارئ بخبرات ورؤى لن ينالها من خلال أيّة أداة أخرى غير القراءة، من هنا صارت القراءة قناة أساسية للتواصل والنقل الحضاري بين الأجيال، فإنّه من دون اعتماد الإنسان عليها لا يمكن أن يراكم العناصر المعرفية اللازمة للإبداع والتطور العلمي، فالإبداع فعل عقلي ينجز في سياق امتصاص العقل لمنجزات ومكاسب ومعارف سابقة، ثمّ تفكيكها وتحليل مكوناتها، بغية امتلاك ما يمكن اعتماده كأساس في التفكير العلمي الجديد، بمعنى اننا بالقراءة فحسب نستطيع استيعاب معطيات العقل البشري عبر آلاف السنين، ونبدأ دائماً حيث انتهى الآخرون، فتتسق خطواتنا في سياق الحركة التكاملية للعلم، بينما ستظل خطواتنا تراوح في محلها ولا تغادره، لو لم نقرأ ونتدبر ما انجزه الإنسان منذ فجر التاريخ حتى اليوم.
القراءة وعي متجدد للحياة، واختراق للفضاء الزماني والمكاني المحدود إلى فضاء غائب عنا، وسياحة متوغلة في أعماق التاريخ، واستشراف واعٍ لآفاق المستقبل، فهي تمنحنا رؤية مكثفة للحاضر، عندما تضيف لوعينا باستمرار ما ابدعه عقل الفلاسفة، وما صورته مخيلة الفنانين والأدباء، وما اكتشفه علماء الطبيعة من قوانين. سأل أحد أبناء الفيلسوف وليم جيمس أباه قائلاً: (إذا سألني الناس عن مهنتك، فماذا أقول لهم يا أبتاه؟ فقال: يا بني! قل لهم ان إبي دائم التجوال ليلقى الأدباء والعلماء والمفكرين، من كل عصر وجنس ودين، يصغي إلى الأموات منهم، كما يصغي إلى الأحياء، يصافحهم على الرغم من المسافات الشاسعة التي تفصله عنهم... إنّه لا يعبأ بحدود جغرافية ولا فترات زمانية).
لقد أتاحت القراءة لغير واحد من المشاهير أن يرتقي سلّم النجاح في الحياة بعد أن أخفق في مواصلة الدراسة المنتظمة في معاهد العلم، غير انّه لم ينصرف عن تلقي المعرفة بعد ان اتخذ القراءة هواية يجد فيها أمتع لحظات حياته، وربما تعمقت تلك الهواية فاصطبغت بها سائر همومه واهتماماته، واستحالت إلى ملكة راسخة – حسب تعبير القدماء – طبعت شخصيته واتسمت بها حياته. فصار يطوي مدارج العلم والمعرفة، ويرتقي كل يوم، فكل قراءة جديدة هي معرفة جديدة، وكل كتاب يطالعه يمنحه رؤية لم يخبرها من قبل، صحيح انّ هذه الرؤية لا تنبثق فجأة، لأنها قد تظل غاطسة في عقله، بيد انها ستساهم في إعادة تشكيل وعيه بما حوله، حينما تندمج بالمكونات القبلية لوعيه. يقول أحد المفكرين: "كم من رجل أرخ عهداً جديداً من حياته من يوم قراءة كتاب".
- ماذا نقرأ؟
طالما ردد هذا السؤال كثير من الناس، وهو سؤال له ما يسوغه، ولا سيما بعد تدفق هذا الكم الهائل من الانتاج الفكري، الذي يصدر على شكل مؤلفات، ومترجمات، وبحوث ومقالات تنشرها الصحف والدوريات، وله ما يسوغه من جهة أخرى أيضاً، بعد ملاحظة تنوع قنوات المعرفة، وتداول وسائل جديدة مثل شبكة الانترنيت وما تحمله من فيض واسع من المعارف والمعلومات بشتى الأشكال. غير انّ هذا السؤال يستبطن تصوراً خاطئاً لدور القراءة في عملية التثقيف أوّلاً، ولنسق العلاقة في داخل المعرفة البشرية بين العلوم والمعارف ثانياً. وينشأ هذا التصور مما يتوهمه بعضهم بشأن مسألة التثقيف، عندما يخال انّ التثقيف هو عملية آلية ميكانيكية تتحقق ذروتها في مطالعة مجموعة كتب معينة، تتيح للفرد أن يساهم في مختلف الفعاليات والأنشطة الفكرية من كتابة وتأليف وحوار فكري وغير ذلك من المهام الثقافية. وعندئذ لا تعود لديه أية حاجة للتواصل مع معطيات الفكر المتجددة، ومواكبة حركة الانتاج الثقافي اليومية، لأنّ تلك المجموعة من الكتب تشتمل على القول الفصل في تمام حقول المعرفة. وقد عمد بعض الإسلاميين لترسيخ هذا التصور لدى قطّاع من الناشئة، عبر تأكيدهم المبالغ فيه على مؤلفات مفكر أو كاتب معيّن وتجاهلهم لما سواه، مثلما يفعل بعضهم ازاء كتابات المرحوم تقي الدين النبهاني، فيصطنع لها مرتبة في سلم الفكر الإسلامي لا ترقى إليها أيّة أعمال أخرى، ويضفي عليها نعوتاً تجعلها شافية كافية لجميع المتطلبات الفكرية في حياتنا. وكأنها تنبئ عن الكلمة الأخيرة في تمام حقول المعرفة.
وقد ينجم عن ذلك أن تتمدد مقولات بعض الكتّاب والمفكرين خارج زمانها الخاص، ويعمم إنتاجه إلى تمام الأزمنة اللاحقة، وتُهيمن رؤاه ومفاهيمه على الحياة الثقافية، كما لو أصبح كتابه فقط هو المصدر الوحيد للتلقي، والرافد الوتر للتثقيف، فيُعنى المتأخرون بشرحه وتأويل نصوصه، والاستغراق في مشكلات تفصيلية ترتبط بتجديد مداليلها. وهذا يعني استقطاب الحركة الفكرية وتمحورها حول هذا الكتاب، مما يفضي إلى تعطل هذه الحركة وتحولها إلى حركة تكرارية تراوح في محلها.
وربما تتعرض الحركة الفكرية لإنشطار في الرؤية يؤدي إلى حالة معاكسة، حينما تصاب الذاكرة بثقب يتسبب في نسيان مفكرين كبار واهمال أعمالهم مدة طويلة، كما حصل مع ابن خلدون. ان كلتا الحالتين تعبران عن موقف خطأ، فبينما ينقلب النسبي إلى مطلق في الحالة الأولى ويتحول قوله إلى نص يستنفذ طاقة الفكر في تفسيره واستنطاقه، تُهمل في الحالة الثانية العناصر الحية في أعمال مفكر عظيم، بينما هي لا غنى عنها في أية محاولة للإبداع والتطور.
في هذا الضوء يمكن القول إن عملية التثقيف تستقي من القراءة الحرة المستمرة، التي لا تختص بلون واحد من المعرفة، أو بما هو منتقى من الكتب والمقالات، ذلك (انّ القارئ الذي لا يقرأ الا الكتب المنتقاة كالمريض الذي لا يأكل إلا الأطعمة المنتقاة، يدل ذلك على ضعف المعدة أكثر مما يدل على وجود القابلية) حسب تعبير عباس محمود العقاد. غير إنّ ذلك لا يعني استنفاذ العمر في قراءات فوضوية تدور حول الغرائب والمسليات خاصة، بل يعني ضرورة تحرك القراءة في رافدين متواشجين يغذي أحدهما الآخر، ينحى الأول منحى افقياً يستطلع ألفباء المعارف البشرية، فيما يتجه الثاني في منحى عمودي رأسي ينصب على تنمية تخصص محدد يستجيب للاستعداد والميل الذاتي للقارئ. ولما كانت المعرفة تمثل منظومة مترابطة، فلا يمكن أن تستغني القراءة الرأسية التخصصية عن المفاهيم والرؤى التي تنجزها القراءة الأفقية المنبسطة على مساحة واسعة من المعارف. أما لو اتجهت القراءة صوب الكتب والأبحاث التخصصية، واقتصرت عليها فقط، فإنّ هذه القراءة لا تمنح العقل نظرة شمولية ممتدة تتجاوز الأفق المحدود لذلك التخصص، وانما تتسبب في نمو معرفة ذات بعد واحد، تختزل الثقافة في إطار هذه المعرفة، وتحيلها إلى مجموعة أفكار ومصطلحات مفرغة من ديناميكية وحيوية الفكر، غير ان ذلك لا يعني الدعوة لإحالة القراءة إلى ممارسة عبثية تشتت طاقة العقل في الجري وراء الموضات الفكرية، فيما تهمل التركيز على لون معيّن من المعرفة، وتنمية الخبرة في حقلها الخاص. وانما يعني انّ القراءة الرأسية التخصصية يجب أن تنشأ في فضاء القراءة الأفقية، مثلما هو الحال في مراحل التعليم التي تبدأ عادة بمراحل تمهيدية تعتمد على دراسة أولية لشتى المعارف والفنون، ثمّ تتجه بالتدريج نحو التخصص في حقل معيّن فيما بعد. وان كانت القراءة الأفقية ينبغي أن تواكب القراءة الرأسية، ولا تنفك عنها في المراحل التالية، لا كما يجري في مراحل التعليم المتعارفة تماماً، لأنّ الأخيرة تظل تستقي من الأفقية، وتستلهم منها في نموها وتكاملها. ولعل أبرز نموذج يمثل هذا الاتجاه في العصر الحديث، هو ما عُرِف بـ"مدرسة فرانكفورت" التي أسسها أربعة من الفلاسفة وعلماء الاجتماع في معهد البحث الاجتماعي بجامعة فرانكفورت في ألمانيا سنة 1923، وجاءت أبحاثها تحقيقاً لمشروع مشترك، يعمل عليه هذا الفريق، إذ كان "هوركها يمر" يأخذ الموقف، ثمّ يتولى زملاؤه البحث: "بوكوك" في الاقتصاد السياسي، و"فروم" في التحليل النفسي، و"لوفنتال" في النقد الأدبي والتحليل النفسي وعلم الاجتماع عامة.
ويمكن أن نجد أمثلة متعددة على الترابط العضوي بين وظيفة القراءتين الأفقية والرأسية في أعمال العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي، وكتابه "الميزان في تفسير القرآن" بالذات، فإنّه بالإضافة إلى تخصصه بالفلسفة والتفسير والفقه وأصوله، كان واسع الاطلاع على المعارف الحديثة، ولذا عمل على توظيفها والافادة منها كأدوات في استنطاق النص القرآني حيثما اقتضى ذلك مدلول النص. كذلك بادر الطباطبائي لتشكيل فريق بحث علمي انتقاه من طليعة تلامذته، وعمل معه على صياغة أصول للفلسفة الإسلامية، تستوحي العناصر الحية الفاعلة من التراث الفلسفي الإسلامي، ولا تهمل مراجعة وتقويم ما انتهت إليه الفلسفة والعلوم الإنسانية في الغرب عامة.►
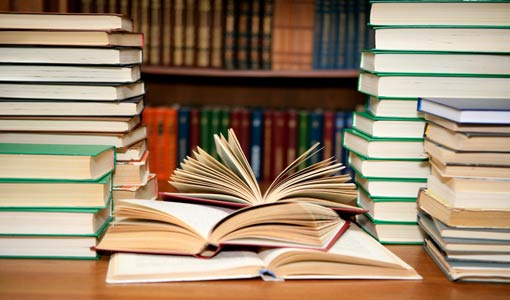
ارسال التعليق