أ. د. عبدالفتاح البزم
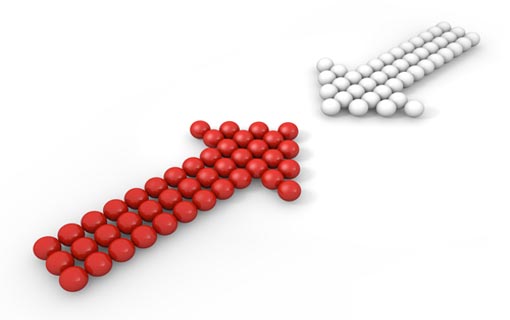
◄الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد..
فأرجو الله أن أوفق في عرض ما استفدته مما ورد عن علمائنا قديمهم وحديثهم في هذا الموضوع الذي كان فيه نتاج غزير، بينوا فيه أصل الخلاف لغة واصطلاحاً وأسبابه وحوافزه التي دفعت أولئك الأعلام إلى الخوض فيه.
إنّ الخلاف في الأصل سنة كونية وطبيعة بشرية، جَبل الله عليها خلقه، وقد جاء ذكر الخُلف في القرآن الكريم في عدة مواضع منها قول الله تعالى: (وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا) (يونس/ 19)، وقوله: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) (آل عمران/ 105)، ولعل أوّل خلاف حدث في التاريخ هو الخلاف الذي حدث بين قابيل وهابيل ابني سيدنا آدم (ع)، وقد أدى ذلك إلى قتل الأخ أخاه، فقتل قابيل هابيل كما بيّن ربنا – جلّ جلاله – ذلك في سورة النساء.
- الفرق بين الخلاف والاختلاف:
جاء في المصباح المنير في مادة خلف: وتخالف القوم واختلفوا إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر، وهو ضد الاتفاق، والاسم الخلف، هذا من حيث اللفظ لغة، أما من حيث المصطلح: فللعلماء في استعمال هذا الاصطلاح رأيان، فمنهم من يرى أنهما لفظان مترادفان، يُستعمل كل واحد منهما في الدلالة على نقيض الاتفاق سواء نشأ ذلك عن دليل أم عن غير دليل، ومنهم من خص لفظ الاختلاف بما كان ناشئاً عن دليل، ولفظ الخلاف بما كان ناشئاً عن غير دليل.
ولا شكّ أنّ هذا مجرد اصطلاح، أما في أصل اللغة فلا يوجد فيه هذا التباين. ومن الخلاف في الحقيقة ما هو مقبول، ومنه ما هو مذموم، بالخلاف المقبول هو الذي يكون سببه الاختلاف في الفهم والاجتهاد في فروع الدين.
وأما الخلاف المذموم فهو الذي يكون بسبب التعصب واتباع الهوى، وهذا الخلاف يسبب الفرقة والتباغض، ونرجو أن يختفي من واقع المسلمين.
ولعل نشوء قضية الاختلاف محمدة نجمت عن عدم محاباة العلماء بعضهم لبعض، وهو من أعظم مزايا هذه الأُمّة، حيث حفظها الله عن وصمة المحاباة، تلك التي تؤدي إلى التغيير والتحريف، فلم يترك علماؤنا لقائل قولاً فيه أدنى دخل إلا بينوه، حتى اتضحت الآراء، وانعدمت الأهواء، ودامت الشريعة الواضحة بيضاء نقية ملأت الآفاق بأضوائها، وأنارت لأبناء هذه الأمة دروبها، مأمونة من التحريف مصونة عن التصحيف. ولقد أشاد القرآن الكريم بالوحدة، واتفاق الكلمة، والاعتصام بالعروة الوثقى، ونبذ التشتت والفرقة، فقال سبحانه: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103).
وبهذه الكلمات القرآنية المعدودات جاء بيان الله سبحانه آمراً بتوحيد الكلمة والاعتصام بحبل الله المتين، وزاجراً عن التفرق والتشتت والاختلاف، وذلك لأنّ اختلاف الكلمة يضر عندما يكون صادراً عن ميول وأهواء، وهذا هو الذي نزل الكتاب بذمه في غير واحدة من آياته، يقول سبحانه: (إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ) (الأنعام/ 159). ويقول: (وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ) (آل عمران/ 105)، اي لا تكونوا كهؤلاء الذين اختلفوا بعد ما تمت عليهم الحجة، وبانت لهم الحقيقة، فقد كان اختلافهم أنانية وحظوظ نفس وهوى.
وأما إذا كان الاختلاف موضوعياً نابعاً عن حب تحري الحقيقة وكشف الواقع، فهذا أمر ممدوح، وأساس للوصول إلى الحقائق المستورة، وإرساء لقواعد العلم ودعائمه. إنّ الاختلاف بين الفقهاء أشبه بالخلاف الذي وقع بين نبيين كريمين: داود وسليمان، على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، في واقعة واحدة حكاها سبحانه في كتابه العزيز وقال: (وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ * فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا) (الأنبياء/ 78-79).
وكما آتى سبحانه لكل منهما حكماً وعلماً، فقد آتى لكل فقيه رباني فهماً وعلماً، يدفعه روح البحث العلمي إلى إجراء المزيد من الدقة والفحص في الأدلة المتوفرة بين يديه، بغية الوصول إلى الواقع، هذا العمل بطبيعته يورث الاختلاف وتعدد الآراء. ولأجل ذلك نجم الاختلاف في الشريعة بعد انتقال النبي (ص) إلى الرفيق الأعلى، واتسعت أبحاثه في القرن الثاني والثالث، فنتج عن ذلك كثير من المؤلفات في هذا الباب، ولنتحدث عن نشأة الخلاف وأسبابه.
- ظروف نشأة الخلاف:
إنّ من ينظر إلى ظروف نشأة هذا الخلاف في مسائل الفقه يجد أنّه يرجع حصوله لحالات كثيرة، لكنه سرعان ما يزول ويرجع أحد المختلفين إلى رأي الآخر، لما تبين له أنّ قوله هو القول الحق، وذلك إما لكونه عارفاً بهذا الدليل، ولكنه كان غائباً عن ذهنه، وإما لكونه غير عارف به أصلاً ولم يطلع عليه.
وقد يذكر العالم المجتهد الآية أو الحديث، ولكنه يتأول فيهما تأويلاً من تخصيص أو نسخ أو معنى آخر، ومن أمثلة هذا النوع ما فات عن كبار الصحابة من سنن النبي (ص) لأسباب منها انهم كانوا ذوي معايش يطلبونها، وكانوا في ضنك من العيش، فمن تاجر يعافس الدنيا طلباً لقوته وقوت عياله، أو ما يجهز به نفسه للغزوات الكثيرة، وكانوا مع كل ما هم فيه من شدة وضيق حريصين كل الحرص على ألا يضيع أحد منهم فرصة في الجلوس والاستفادة منه، إذا وجد أدنى فراغ مما هو فيه، وكان بعضهم أوفر حظاً عند النبي في هذا الجلوس من بعض، وذلك لقلة مشاغله لكونه لا زوجة له ولا أولاد، فكان أكثر سماعاً من النبي (ص).
لقد نشأ التأليف في هذا الباب مبكراً بعض الشيء، فقد ورد في مقدمة مصحح كتاب (اختلاف الفقهاء) للإمام العلامة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري المتوفى سنة 310هـ قوله: أما بعد فلا يجهل أحد أنّ الإمام العلامة أبا جعفر محمد بن جرير الطبري من أشهر علماء المائة الثالثة وأفضلهم، وأن تصانيفه من أجود الكتب وألزمها فائدة، ثمّ كان من قوله في (فصل في علم الاختلاف): وقد اهتم كثير من العلماء بعلم الاختلاف وصنفوا فيه كتباً عديدة جمعوا فيها أقوال الأئمة على اختلافهم في فروع الشريعة، ولكن أكثر ما طبع منه للآن تأليفات المتأخرين إلا أنّ الشيخ العالم مصطفى القباني الدمشقي طبع تأسيس النظر للدبوسي، فأنا أذكر فيما سيأتي ما يوجد في بعض المكاتب من الكتب المتخصصة بالاختلاف إلى حدود الستمائة.
- أسباب الاختلاف:
أما الحديث عن أسباب الاختلاف فقد ذكر العلماء أنّ هناك أسباباً نتج عنها الاختلاف في كثير من الأحكام الشرعية ولعل من أهمها:
أ- الاختلاف في أصول التشريع بعد القرآن والسنة والإجتماع، فبعضهم قدم القياس، وبعضهم الآخر توسع بالأخذ بالمصالح المرسلة، وهكذا.
ب- تعارض الجرح والتعديل، ولعل أوّل ما يلفت النظر في كتب الجرح والتعديل، ظاهرة التعارض في أقوال النقاد في الراوي الواحد، حيث يوثقه بعضهم ويجرحه آخرون.
ت- الاختلاف في فهم نص آية أو حديث لاحتمال ذلك.
فقد يتفق العلماء في الحكم على الحديث وثبوته عندهم، ولكنهم يختلفون في الفهم لنص الحديث فقوله (ص): (لا يمس القرآن إلا طاهر) اختلف فهم العلماء في دلالة كلمة (طاهر) فقد تدل على طهارة الحدث الأكبر أو الأصغر، وقد تدل على طهارة الجسم من النجاسة، ومن هنا كان الاختلاف في حكم مس المصحف الشريف على وضوء أو بدونه.
ث- الاختلاف في الترجيح بين النصوص:
يرجع اختلاف العلماء في تأويل الأحاديث وترجيح بعضها دون الآخر إلى اختلاف فهمهم لتلك الأحاديث، ولا يعني ذلك إنكاراً لحديث على حساب الآخر، بل هو ترجيح محض وفق ما اتخذوه من مناهج في ذلك، ومن أمثلة لك موقف الإمام الشافعي – رحمه الله – بعدم الأخذ بالحديث الصحيح فيما رواه الشيخان من أنّ النبي (ص) لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي قال: (ليس لأحد بلغته سنة عن رسول الله (ص) أن يدعها لقول أحد) ولكنه في استنباطه للحكم لم يكن معتمداً على ظاهر الحديث فحسب.
ولقد رد ابن رشد فيما ذكره من حافز الاختلاف بين الفقهاء إلى أمور ستة:
1- تردد الألفاظ بين أن يكون اللفظ عاماً يراد به الخاص، أو خاصاً يراد به العام، أو عاماً يراد به العام، أو خاصاً يراد به الخاص، أو يكون له دليل الخطاب أو لا يكون له.
2- الاشتراك في الألفاظ، وذلك إما في اللفظ المفرد، كلفظ (القرء) الذي يطلق على الأطهار والحيض، وكذلك لفظ الأمر الذي يحمل على الوجوب أو الندب، ولفظ النهي الذي يحمل على التحريم أو الكراهية.
3- اختلاف الإعراب.
4- تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة، أو حمله على نوع من أنواع المجاز.
5- إطلاق اللفظ تارة، وتقييده تارة.
6- التعارض في الألفاظ أو في الأفعال، أو في الإقرارات، أو في القياسات.
ولندرك بعد هذاكله أنّ الخلاف الذي كان يحصل بين العلماء كان في الغالب يراعى فيه أدب الخلاف وأسلوب الحوار، لأنّ الدوافع في الأصل نبيلة وحرة يسعى فيها أولئك الأثبات إلى البحث عن الحقيقة، حريصين على رضا ربهم سبحانه وتعالى. وهنا نستطيع أن نقول وبشكل واضح: إنّ توحيد الأُمّة الإسلامية على رأي واحد ما هو إلى تعصب لأحد الأقوال دون غيره، ولن يزيد الأمر إلا تعقيداً، لأنّ سلف الأمة من الصحابة والتابعين كانوا أكثر علماً بهذه القضايا، وأقرب إلى النبع الصافي، ورغم ذلك فقد اختلفوا فيما ذهبوا إليه من آراء وأحكام، كما بيّن ذلك صاحب كتاب "أدب الخلاف" فقال: "الأصل في علماء الإسلام ودعاته ورجاله أنهم لا يختلفون رغبة في الاختلاف، ولا حباً في النزاع، ولا يكون دافعهم الشهرة، وإنما بحثاً عن الحق ورغبة في رضوان الله تعالى، وحينئذ فلابدّ أن يكون لكل صاحب قول دليل، أو لكل أهل مذهب دليل يستدلون به، أو أدلة يستدلون بها، ولا يجوز لك أن تأخذ أدلة القول لمذهب أو لجماعة من خصومهم وممن يخالفهم ما دام يمكنك معرفة أدلتهم مباشرة أو مشافهة، وإما من كتبهم، وإما من خلال نقل الثقات من تلاميذهم.
إنّ الاختلاف الذي يكون سببه ما ذكر آنفاً لا ينبغي أن يحدث فرقة بين المسلمين، بل يجب أن تتسع له صدور العلماء، وأن يحسنوا الظن بالمخالف، لأنّ هذا الخلاف لا يمكن القضاء عليه، فهو موجود من بداية البشرية وسيستمر إلى قيام الساعة. من ظن أنّه سيأتي يوم يجتمع فيه المسلمون على رأي واحد في فروع الفقه أو العقيدة فهو واهم وذلك ضرب من الخيال.
وإذا أردنا في وقتنا الحاضر أن نسعى صادقين إلى جمع الشمل ووحدة الصف فعلينا أن ننظر بعين التدقيق إلى ما يساعد على تجاوز أزمة التباين والتفرق، ولعل في مقدمة ذلك فيما رآه أهل الرأي والغيرة على مصالح الأُمّة السعي إلى إعداد ميثاق للعمل يشارك فيه جميع العاملين في حقل الدعوة للإسلام من أهل القبلة الواحدة نابذين الفرقة ساعين إلى الوحدة، مخلصين في سعيهم لله تعالى.
ومما يعين على ذلك أمور منها:
1- تعويد المهتمين بأمور الدعوة على أن يكون المرجع عند الاختلاف الكتاب والسنة، وما كان عليه الجيل الأوّل في نأنأة الإسلام.
2- البعد عن الافتراق المذموم والعمل على الاستجابة لقول الله تعالى: (وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلا تَفَرَّقُوا) (آل عمران/ 103)، ولا يكون ذلك إلّا بوضع مناهج تؤدي إلى جمع شمل الأُمّة بصدق وإخلاص.
3- بدء التعاون فيما تم الاتفاق عليه، وإرجاء ما بقي معلقاً إلى مراحل قادمة.
4- التواصي على عدم التجريح والمبالغة في الإنكار، وجعل الصدر واسعاً رحباً فقد كاد الحليم أن يكون نبياً.
5- الاستفادة من جهود وخبرات كل من تدرجوا في حل الخلافات الناشئة فيما بينهم، والعمل بقول النبي (ص): "الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها".
وإننا نرى الآن أنّ أمم الأرض تتجمع وتتكتل تحت عناوين مختلفة، وقد لا يجمعها دين ولا عرق، وفي الوقت نفسه نزداد نحن المسلمين تشرذماً وتمزقاً، وديننا واحد، ووطننا واحد على امتداده، وثرواتنا لا تحصى، ونحن غثاء كغثاء السيل، يصدق فينا قول النبي (ص) في ذلك.
وهنا نقطة لابدّ من تسجيلها وهي أنّ أزمة الأمة اليوم أزمة نخب وليست أزمة شعوب، فالشعوب أثبتت في مواطن كثيرة أنها مع هذا الدين، ولكنها لا تجد من هم قادرون على جمعها عليه، وهذه حقيقة يجب أن نعترف بها، وأن نبذل الوسع في سبيل تلافي ما يمكن تلافيه، وتدارك ما يمكن تداركه، وتسخير جميع الوسائل في سبيل ذلك. نستنتج مما سبق أنّه لا يوجد مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر في هذا الكون يقصد أن يخالف سنة النبي (ص) سواء كانت قولية أو فعلية لمجرد المخالفة، إنّ كل مسلم إما أن يكون مجتهداً أو مقلداً وعموم الناس مقلدون، والمجتهدون قلة في جميع الأزمان والعصور، وبالنسبة للقضايا العقدية وقضايا الفقه المعلومة ليس هناك من جديد يمكن أن يضيفه المجتهدون في هذا الزمان، إذ قضية الحفاظ على الثوابت أمر مسلم به بدهياً.
لذا على كبراء الأمة ونخبتها من علماء ومفكرين وسياسيين أو يتقوا الله في أمتهم، وأن يعملوا جاهدين على وحدة الصف وجمع الكلمة، وفي طليعة أولئك علماء الأمة على اختلاف مذاهبم ومشاربهم، وأن يذكروا الوقفة بين يدي الله تعالى، وفي أعناقهم تلك الأمانة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأود أخيراً أن أشير إلى الخطوة الكبيرة التي قام بها الإمام الأكبر الراحل شيخ الأزهر الشريف محمد شلتوت – رحمه الله تعالى – في مجال التقريب بين المذاهب عندما سئل عن جواز التعبد بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية، فأجاب:
1- إنّ الإسلام لا يوجب على أحد من أتباعه اتباع مذهب معين، بل تقول: إنّ لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره – أي مذهب كان – ولا حرج عليه في شيء من ذلك.
2- إنّ مذهب الجعفرية المعروفة بمذهب الشيعة الإمامية الاثني عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعاً كسائر مذاهب أهل السنة.
فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، يتخلصوا من العصبية، بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته بتابعة لمذهب، أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز لمن ليس أهلاً للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات. أخلص في نهاية المطاف بعد هذا العرض إلى حقيقة ينبغي أن تكون نبراسنا الذي نهتدي به، هي أنّ الدين عند الله الإسلام، وأنّه من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه، وأنّ رسولنا الكريم (ص) تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وترك فينا أمرين ما إن تمسكنا بهما فلن نضل أبداً، كتاب الله المحفوظ بحفظه سبحانه، وسنته الطاهرة عليه الصلاة والسلام. وما كان عليه أهل بيته وأصحابه رضي الله عنهم جميعاً فلو تمسك عامة المسلمين اليوم بهذه الثوابت، وعرفوا للصدر الأوّل من المسلمين أقدارهم، وأخلصوا دينهم لله، بعيدين عن النزعات والتوقعات، مفكرين بصدق بمستقبل هذه الأمة لكان الفجر المرتقب الذي ترنو إليه أعين الجميع، ليعود لهذه الأُمّة مجدها وعزها وسؤددها، وليس ذلك على الله بعزيز.
والله ولي التوفيق.
المصدر: مجلة رسالة التقريب/ العدد 88 لسنة 2011م
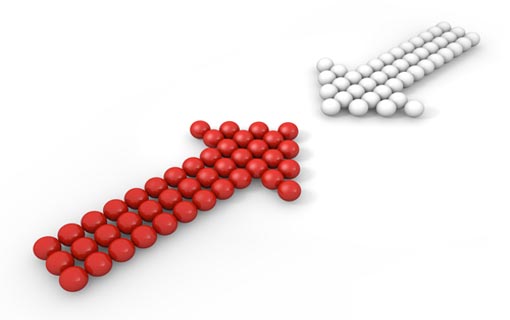
ارسال التعليق