تعد الكلمة أوّل الفنون التي عرفها البشر، ولم تكن معرفتهم بها عن طريق الاكتشاف أو الاختراع، وإنما عن طريق التعلم، وكان ذلك بفضل الله تعالى حيث علّم آدم الأسماء، وما كان ذلك إلا إكراماً له، وتمييزاً له عن بقية المخلوقات.
(وَعَلَّمَ آدَمَ الأسْمَاءَ كُلَّهَا...) (البقرة/ 31).
وكانت الكلمة هي الواسطة التي تفاهم بها البشر فيما بينهم، وما زال الناس – وبعد افتراقهم إلى شعوب وأمم، وبعد تعدد لغاتهم – يسعون في تحسين لغاتهم، فينتقون الألفاظ ويتخيرونها، ويستبعدون بعضها في سبيل تجميل ألفاظهم معنى وجرساً.
وكان العرب في مقدمة الأُمم التي اعتنت بلغاتها، وكان صناع الكلمة هم ذوو المكانة عندهم، فالخطيب هو سيد القبيلة الذي يتكلم بلسانها والشاعر هو إعلامها الذي يرفع منزلتها ويفاخر بها.
وتبوأت الكلمة المكانة المرموقة لديهم، فأقيمت لها معارض وأندية تلقى فيها الخطب، وتنشد فيها القصائد... ويحكم النقاد بعد ذلك، لهذا أو لذاك...
وكان "عكاظ" واحداً من هذه الأندية، التي تجتذب إليها الأدباء من شعراء وخطباء فيشدون إليه الرحال، كما يفعل ذلك التجار أيضاً بغية البيع والشراء وتبادل السلع.
وإذا كانت القوة هي مصدر رفعة القبيلة، فقد كانت بلاغة الكلمة هي المصدر الآخر لهذه الرفعة. وفي قصة وفد بني تميم إلى النبي (ص) ما يوضح ذلك ويبينه، فقد قالوا جئنا نفاخرك... وطلبوا الإذن لشاعرهم ولخطيبهم... ثمّ اعترفوا بعد ذلك بأنّ شاعره (ص) أشعر من شاعرهم، وأنّ خطيبه أخطب من خطيبهم...
ولئن كانت سوق الشعر رائجة أكثر من الخطابة، فما ذلك لقلة شأنها، وإنما لكثرة أغراض الشعر... بينما ظلت الخطابة محدودة الأغراض، فهي لمناسبات معينة.
إنّ الكلمة هي الفن الوحيد الذي برع فيه العرب، فكان له من التقدير والاحترام ما استطاعت به لوحاتهم الفنية أن تتبوأ أسمى منزلة وأعلى مكانة يطمح إليها نتاج بشري... فأضحت (معلقات) في جوف الكعبة المكان الذي هو مهوى أفئدتهم جميعاً ومطمح أبصارهم...
إنّه نوع من القداسة يعطى للكلمة لم يكن لها مثله في أمة ما...
إنّهم كانوا يظنون بأنفسهم أنها وصلت القمة... ولعل هذا ما يفسر لنا بعض الحكمة في أنّ القرآن تحداهم فيما يتقنون وفيما يعتبرون أنفسهم فيه مهرة سابقين.
كانت الكلمة يومئذ شعراً ونثراً... والخطابة من النثر، ثمّ دخلت أغراض جديدة منها: القصة والمسرحية...
وليس من غرض هذا البحث الخوض في هذا الميدان المترامي الأطراف. فهو موضوع قائم بذاته، بل كلّ فرع منه أضحى فناً متكاملاً له مقوماته ومقاييسه الجمالية، ولكن الغاية هي لفت النظر إلى بعض الملاحظات العامة التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار حينما نتحدث عن فن الكلمة.
وما زالت الكلمة هي الفن الأول لدى جميع الشعوب بل والأساس في أكثر الفنون.
إنّ الإسلام بمنهجه العظيم، تجاوز بالفكر الإسلامي حدود القبيلة والشعب ليصل به إلى "الإنسان". وتجاوز حدود البلد والأقليم... إلى الأرض بل إلى الكون... تجاوز به الآفاق الضيقة ليضعه أمام مجال فسيح هو: الإنسان كله... والكون كله... والحياة كلها... دنياها وأخراها.
إنّه منهج للفكر ومنهج للحياة. ومع هذا فهو السماء في عالم الكلمة، ترنو إليه كلمات الأرض مستضيئة بلألاء كلماته، فإذا نورها في عليائه يضيء للسالكين طريقهم، ويفتح لهم الآفاق تلو الآفاق.
وكان حرياً أن يكون عطاء الكلمة عظيماً في ظل هذا المنهج. والسؤال المطروح: هل استفاد فن الكلمة من الفرصة الهائلة التي أتاحها له الإسلام؟
ذهب بعضهم إلى التأكيد بأنّ الأدب العربي قد خسر خسارة فادحة حيث لم يستفد من ذلك الرصيد الضخم الذي قدمه الإسلام، ولهذا الاتجاه وجهة نظر قوية ولكنا نريد إبداء بعض الملاحظات.
إنّنا لا نستطيع نفي التأثير القوي الذي طبع به الإسلام فن الكلمة ولكنا نقول: يبدو أنّ هذا التأثير لم يكن بالحجم المطلوب، أو هكذا يبدو الأمر للوهلة الأولى.
كما يبدو أيضاً أنّ فن الرسم كان أكثر التزاماً من فن الكلمة.
فما هي الأسباب؟
ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال... فذلك أمر يحتاج إلى بحث خاص يكون فيه سبر وتقص... ولكن يمكننا من خلال الملاحظات التي وعدنا بالحديث عنها أن نكون أمام بعض الجوانب.
التصنيف:
إنّ قضية التصنيف لها أهمية كبيرة في إبراز النقاط التي يريد المصنف إظهارها، وقد صنف الشعر في الماضي – حينما بدأت عملية الجمع والتسجيل – وفق الأغراض التي بدا للجامعين والأدباء أنها الأبواب التي يمكن أن يصنف تحتها الفن، فكان منها: المديح والفخر والهجاء والرثاء.. وكانت تلك هي الموضوعات التي غلبت على الحياة الجاهلية، ولم يجد الجامعون والمصنفون حرجاً في أن تكون تلك الأغراض هي العناوين لما يجمعون.. وهكذا بدأت عملية التصنيف واستمر هذا الأسلوب...
هذه الطريقة لم تتح للأغراض الجديدة التي أتى بها الإسلام أن تأخذ مكانها كأغراض مستقلة لها مقوماتها، فكان أن انضوت تحت أقرب الموضوعات إليها، وهذا واحد من الأسباب التي جعلت فن الأدب يبدو مقصراً في استفادته من الرصيد الإسلامي الكبير.
ولو أتيح للأدب تصنيف جديد، تراعى فيه مقاصد غير تلك التي صنف تحتها في الماضي، فربما تتغير النظرة، ويبدو على السطح ما كان وراء حجاب، وهناك من المحاولات ما يؤيد وجهة النظر هذه. فقد عمد بعضهم إلى شعر الطبيعة فجمعه، فوجد من الشعر ما يكوِّن مادة بحثه[1]، وقام آخرون بجمع الشعر الإسلامي تحت عنوان "شعر الدعوة الإسلامية" فاستطاعوا أن يجمعوا مادة ليست بالقليلة[2].
شعر القصور:
نلاحظ في عملية التسجيل أنها اهتمت بالشعراء المقربين من قصور الخلافة والإمارة. وهؤلاء يمثلون الإعلام في عصورهم، وهم بالتالي لا يمثلون إلا تلك الزاوية التي يصدرون عنها. وغالب شعر هؤلاء يكون وفق الأغراض الجاهلية، وفي المقابل، لا نشك بأنّ هناك شعراً آخر ربأ أصحابه بأنفسهم أن يكونوا على الأبواب، وهؤلاء – في الغالب – هم الذين يمثلون الالتزام، وبالطبع لم يتح لشعرهم أن يتبوأ مكانته.
الجانب المهمل:
هناك شعر كثير. لم يعط حقه من العناية والرعاية، وغض النظر عنه، إما بدافع حسن النية، اجتهاداً من بعضهم، وإما بدافع الإهمال... وقد أشار إلى هذا الجانب وقيمته الدكتور نجيب الكيلاني، فكان مما قال:
"ومن أجمل الشعر العربي شعر التصوف الذي يسيل رقة وعذوبة وشفافية، ذلك الشعر الذي صور عالم الروح، وعالم ما وراء الطبيعة بانفعالاته والغامضة في جمال... وناقش هذا الشعر قضايا الوجدان والحب الإلهي، ومشاكل الحياة والوجود وأكثر من الابتهالات والتسبيحات المشرقة المنيرة".
"وفيه لمحات عميقة عند الحديث عن النفس وأهوائها ونزعاتها..."
"وفيه إلهيات وزهديات من أرق وأروع الشعر على الإطلاق..."[3].
وتحدث عن جانب آخر فقال:
"هناك أدب رائع للمعتزلة وللخوارج..."[4].
والحقيقة أنّ هذا الجانب من الأدب لا ينبغي إهماله، وإذا كان الأستاذ محمد قطب يعد أدب "طاغور" أدباً إسلامياً[5]، فيضعه بين نماذج الأدب الإسلامي، فمن باب أولى... أن يرجعَ إلى هذا الأدب، وتستخرج روائعه، فلا شك أنّ فيها الكثير من الخير الذي لا ينبغي تركه كله لانحراف بعضه. وهؤلاء أولى "بالإسلامية" من طاغور لأنهم مسلمون في تصورهم على الأقل.
الخطابة:
كانت تلك بعض الأسباب التي جعلت فن الكلمة يبدو مقصراً في استفادته من العطاء الإسلامي الواسع.
وسبب آخر، هو أننا غالباً ما نقصر فن الكلمة على الشعر والنثر، ونهمل الخطابة، أو لا نضعها في مكانها الصحيح.
"والخطابة هي فن الحديث إلى الناس".
وقد كانت لدى اليونان صنعة كلام وتفنناً في القول.
وكانت عند العرب، قبل الإسلام، مقالة المناسبات، فهي تلقى في عقود الصلح، أو في مناقشة المعضلات التي تنتاب القوم.
وجاء الإسلام..
فكانت الخطابة هي الوسيلة الأولى للدعوة إلى الله تعالى، وتبليغ رسالته، ووقف الرسول (ص) على الصفا ليقول لقريش:
"إنّ الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعاً ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو، إني لرسول الله إليكم خاصة، وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثنَّ كما تستيقظون، ولتجزونَّ بالإحسان إحساناً، وبالشر شراً، وإنها للجنة أبداً، أو النار أبداً، وإنكم لأوّل من أنذر بين يدي عذاب شديد".
ومع كمال هذا الدين، أخذت الخطابة مكانتها، فأصبحت شعيرة من شعائره، ترتبط مع الصلاة في يوم الجمعة، وفي العيدين، ويوم عرفه... وصلاة الاستسقاء... ثمّ في كل وقت يحزب المسلمين أمر، ينادى: الصلاة جامعة، ثمّ يخطب الإمام فيهم.
ومنبر الإسلام هو منبر الحياة، يعالج جميع قضاياها، صغيرها وكبيرها، وبهذا ارتقى الإسلام بالخطابة فجعل منها فناً للكلمة، غلب على ساحة الحياة، يتعامل معها في حيوية ونشاط كاملين... وانزوى الشعر على بعض تلك الأغراض التي تعود أن يتعامل معها.
ولا شك بأنّ الأثر الإسلامي كان عظيماً على هذا الفن، وكما كانت المساجد هي الفن المعماري الذي أنشأه الإسلام، فإنّ الخطابة هي فن القول الذي أنشأه الإسلام أيضاً، وما من شك في أنها كانت موجودة قبله – كما كان فن البناء موجوداً – لكن الإسلام هو الذي أعطاها هذه المكانة، وربطها بالمسجد، فكان لها بعض معانيه، فكان لها بهذا قبس من قدسيته، فاحتلت مكانة التوجيه، والقيادة الفكرية للأُمّة.
ومع هذه المكانة، فقليلاً ما نتحدث عن الخطابة عندما نتحدث عن فن الكلمة، ولعل السبب في ذلك أنّ الخطب المدونة قليلة، وهي بطبيعتها تختلف عن الشعر، إذ الأصل في الخطابة الارتجال، والأصل في الشعر الإعداد المسبق، مما يسهل عملية تدوينه دونها، فقد يحفظ مستمع فقرة من خطبة سمعها أمام أن يحفظها كلها فذلك ليس بالأمر الميسور.
وعدم التسجيل أضاع الشيء الكثير، ومع ذلك فما وصلنا يعد شيئاً لا يستهان به.
وهناك أمر لابدّ من لفت النظر إليه، وهو أنّ الخطبة موقف، وليست مجرد كلمات ينظر إلى بلاغتها وتناسقها وفصاحة ألفاظها.
إنها موقف، ينبغي أن يراعى فيه ملاحظة السامعين، ومستواهم الفكري، ونوعية الموضوع المطروح وأهميته ومدى ارتباطه بواقع الحياة.
والإسلام إذ يتبنى هذا الفن فإنّه ينطلق به إلى مستويات رفيعة، ومن هنا كانت له شروط في شخصية الخطيب من حيث التزامه وثقافته وفكره، وصدقه عاطفة وموضوعاً... ثمّ من حيث مظهره، وكيفية أدائه ولهجته وقوة ألفاظه... وهناك شروط أخرى في موضوع الخطبة من حيث المضمون والشكل...
ونحن لا نريد التفصيل في هذا الشأن فذلك يخرجنا عن حدود الموضوع الذي التزمنا به. وإنما أحببنا الإشارة إليه حتى تكون الفكرة عنه واضحة.
وقد ذهب علماؤنا إلى بيان ما ينبغي للخطيب أن يلزم نفسه به حتى يؤدي واجبه كاملاً. ويصل إلى الغاية المطلوبة. وكان من جملة ذلك بيان الأسلوب الذي يحسن به أن يطرقه حتى يؤدي واجبه على الوجه الأكمل. وكانت كلماتهم في ذلك تنم عن الخبرة الواسعة والبصيرة النافذة، والمعرفة العالية في الوصول إلى دخائل النفوس.
قال ابن القيِّم – رحمه الله – يتحدث عن أسلوب العارف بالموعظة:
"العارف لا يأمر الناس بترك الدنيا، فإنّهم لا يقدرون على تركها، ولكنه يأمرهم بترك الذنوب، مع إقامتهم على دنياهم. فترك الدنيا فضيلة، وترك الذنوب فريضة، فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم بالفريضة. فإن صعب عليهم ترك الذنوب، فاجتهد أن تحبب الله إليهم، بذكر آلائه وإنعامه وإحسانه، وصفات كماله، ونعوت جلاله، فإنّ القلوب مفطورة على محبته، فإذا تعلقت بحبه هان عليها ترك الذنوب والاستقلال منها والإصرار عليها".
ويتحدث عن الفارق بين أسلوب العارفين وأسلوب الزهاد فيقول:
"العارف يدعو الناس إلى الله من دنياهم، فتسهل عليهم الإجابة، والزاهد يدعوهم إلى الله بترك الدنيا فتشق عليهم الإجابة.."[6].
كانت تلك بعض العوامل التي جعلت فن الكلمة يبدو وكأنّه أقل تأثراً بالإسلام من غيره من الفنون، ولكن إذا أتيح لنا أن ننظر إلى التراث الأدبي مع مراعاة هذه الملاحظات وجدنا أنّ هذا الفن يساير غيره من الفنون في هذا الشأن وليس أقل التزاماً منها.
الهوامش:
[1]- قام الدكتور نوري القيسي بجمع شعر الطبيعة في الحياة الجاهلية تحت عنوان "الطبيعة في الشعر الجاهلي" وطبع في دار الإرشاد في بيروت عام 1390هـ.
وقام الدكتور أنور عليان أبو سويلم ببحث مشابه تحت عنوان "الطبيعة في شعر العصر العباسي الأوّل" طبع دار العلوم 1403هـ.
[2]- تم هذا المشروع تحت عنوان (موسوعة أدب الدعوة الإسلامية) برعاية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وإشراف الدكتور عبدالرحمن رأفت الباشا – رحمه الله – وقد صدر المشروع في خمسة أجزاء. الأوّل تحت عنوان (شعر الدعوة الإسلامية في العهد النبوي) والثاني في العهد الأموي، والثالث في العصر العباسي الأوّل والرابع في العصر العباسي الثاني، والخامس في العصر العباسي الثالث.
[3]- الإسلامية والمذاهب الادبية. دكتور نجيب الكيلاني، ص86-88، ط مؤسسة الرسالة.
[4]- المصدر السابق، ص86.
[5]- قال الأستاذ قطب (... لم نقصر النماذج التي أخذناها من بواكير الأدب الإسلامي على المسلمين من الفنانين، بل اخترنا إلى جانبها نماذج من فنانين غير مسلمين، لأنّها تلتقي – التقاء جزئياً على الأقل – مع التصور الإسلامي وتصلح بذلك أن تسير مع المنهج الإسلامي للفن في هذه الحدود) [منهج الفن الإسلامي، ص266].
وقد سبق لنا في بحث الالتزام – في هذا الكتاب – مناقشة هذه القضية، وكان الاقتراح أن نجد لهذا النوع من الأدب تسمية أخرى. كأن نسميه (فناً راقياً) أو فناً إنسانياً.
[6]- الفوائد، لابن القيِّم، ص294.
المصدر: كتاب الفن الإسلامي.. التزام وابتداع
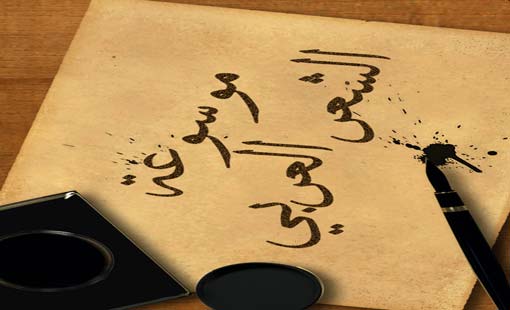
ارسال التعليق