- ١ تشرين ثاني/نوفمبر ٢٠٢٤ | ٢٨ ربيع الثاني ١٤٤٦ هـ
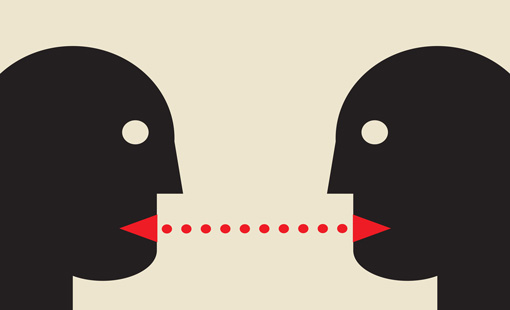
◄تُعدّ مسألة (صدام الحضارات)، أو حوارها من أبرز المسائل المطروحة اليوم على النُّخبة الفكرية والسياسية في المجتمعين: الغربي، والعربي الإسلامي بالدرجة الأولى. ولا غرابة في ذلك فهي لم تبرز بحدّة غداة الفاجعة التي عاشتها مدينتا نيويورك، وواشنطن يوم الحادي عشر من سبتمبر الماضي فحسب، بل نتيجة التحوّلات الكبرى التي مرّ بها العالم بعد سقوط جدار برلين عام 1989م، ثم انهيار الاتحاد السوفييتي، ومحاولة الولايات المتحدة الأمريكية أن تفرض نظاماً عالمياً جديداً، وتزامن ذلك مع محاولة الليبرالية الجديدة المتطرفة استغلال ظاهرة تاريخية إيجابية لم يعرفها تطوّر المجتمعات البشرية من قبل، هي ظاهرة العولمة لفرض إيديولوجيتها، ومقاومة قوى المجتمع المدني في الغرب نفسه المنددة بالجوانب السلبية للظاهرة نتيجة ذلك الاستغلال، ومحاولة الانفراد بزعامتها، وقد ظهرت منظمات وطنية ودولية غربية رسالتها الأساسية كشف أساليب الليبرالية الجديدة لاستغلال العولمة على حساب الفئات الاجتماعية الضعيفة، وعلى حساب شعوب الجنوب بصفة أخص.
ولكن قبل الحديث عن حوار الحضارات أود إبراز النقاط التالية:
أوّلاً - لقد وُلِد العنف في تاريخ المجتمعات البشرية، ولا يزال، عُنفاً مضاداً، ولا يصدر العنف دائما عن الأفراد والجماعات، بل ويصدر في كثير من الحالات عن السلطة الحاكمة نفسها.
ثانياً - نتيجة لتطوّر وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، تحوّل العنف بشتّى أشكاله إلى إرهاب منظّم ذي طابع محلي وطني، أو إلى إرهاب دولي. ولابدّ من الإشارة في هذا الصدد إلى المسئولية الكبيرة المُلقاة على كاهل أصحاب المصالح الرأسمالية في الغرب، وأقصد بهم تجار السلاح أوّلاً، وكذلك الدول، في صبّ الزيت على نار العنف والإسهام في خلق تربة خصبة أنبتت الإرهاب في كثير من البلدان النامية، وفي مقدمتها البلدان العربية والإسلامية.
ثالثاً - إنّ أخطر أنواع الإرهاب هو إرهاب الدول، والنماذج المرعبة لإرهاب الدولة هي نماذج غربية أوروبية في التاريخ المعاصر، مثل إرهاب الدولة في إسبانيا في مرحلة الجنرال فرانكو، أو إرهاب الدولة الإيطالية أيام موسوليني، أو إرهاب الدولة الستالينية، وقتل الملايين وتهجير شعوب بأسرها، كما كشفت عن ذلك أخيراً الوثائق الرسمية للاتحاد السوفييتي، وتمثّل النازية بأوروبا في الأمس، والصهيونية في فلسطين اليوم، قمة إرهاب الدولة والأبرياء هم الضحايا الأوّل لهذا النوع من الإرهاب، ذلك أنّ زبانيته يلجأون إلى العقاب الجماعي، فلما كانت المقاومة في إحدى المدن الأوروبية المحتلة تغتال جنديا ألمانيا، ترد فرق (الجيستابو) بإعدام مجموعة من سكان الحي الذي تمّ فيه الاغتيال، وهو الأسلوب الذي اتبعه الجيش الفرنسي في الجزائر، وهو الأسلوب نفسه الذي تنفذه اليوم الآلة العسكرية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ولابدّ من الجرأة والقول هنا إنّ السياسة الأمريكية قد دعمت، وساعدت إرهاب الدولة في كثير من البلدان، ولا سيما في أمريكا اللاتينية، وقد كشف باحثون أمريكان عن دعمها للحكم الدكتاتوري للجنرال (بينوشيه) في (تشيلي) وهي تبارك اليوم على إرهاب الدولة.
رابعاً - لابدّ من التمييز الواضح بين المقاومة الوطنية المشروعة ضد المحتل الأجنبي، وبين الإرهاب، ذلك أنّ احتلال أراضي الغير بالقوّة يمثّل قمة إرهاب الدولة. وإنّ من أبرز أنواع الخلط المقصود والمخطط له هو استغلال أحداث 11 سبتمبر 2001م لتصنيف بعض حركات المقاومة الوطنية ضمن المنظمات الإرهابية. ومن هنا ارتفعت أصوات كثير من رؤساء الدول ومن قوى المجتمع المدني في الغرب نفسه لتنظيم مؤتمر دولي تحت إشراف الأُمّم المتحدة لتحديد مفهوم الإرهاب، فلا يمكن القضاء على الإرهاب باستعمال سياسة الكيل بمكيالين. وقد غذت هذه السياسة ظاهرة الإرهاب وبرّرتها.
خامساً - ولابدّ أن نؤكد في هذا الصدد أنّ مقاومة النُّظم الاستبدادية التي تسخّر أجهزة الدولة لقمع المواطنين وإرهابهم، هي مقاومة وطنية مشروعة يجب دعمها دولياً مثل مقاومة الشعب في (تشيلي) لحكم الجنرال (بينوشيه)، أو مقاومة شعوب يوغسلافيا سابقاً للنظام الصربي الفاشي بزعامة ميلوسوفيتش، فقد برهنت حرب كوسوفو أنّ الغرب غير مستعد البتة أن يقبل بقيام نظام استبدادي في عقر داره اتعاظاً منه بالتجربة النازية والستالينية، ولكنّه يصمت عن نُظم استبدادية في بلدان العالم الثالث، بل ويغازلها ويتحالف معها مثلما أقامت الدليل على ذلك أخيراً الحرب الدائرة في أفغانستان. فقد كانت الدول الغربية قبل أحداث نيويورك وواشنطن المؤلمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تندد بالنظام العسكري القائم في أحد بلدان المنطقة وتطالب بضرورة العودة إلى التجربة الديمقراطية البرلمانية، أصبح هذا الجنرال الطفل المدلل يتهافت قادة الدول الغربية على خطب ودّه لأنّه وضع بلاده تحت خدمة المصالح الغربية. تلك هي مشكلة أيديولوجيا الليبرالية الجديدة: المصالح قبل الشرعية الدولية، وقبل قيم الغرب نفسه، وقبل حقوق الشعوب، ولا غرابة في ذلك فهي البنت الشرعية للرأسمالية الاستعمارية بالأمس.
سادساً - وينبغي علينا ألا نخلط، ونحن نتحدّث عن الحوار الحضاري، بين وجه الغرب القبيح هذا وبين وجه الآخر المشرق، وجه التقدم ووجه الذود عن حرّية الشعوب وحقوق الإنسان. إنّ ممثلي هذا الوجه هم الذين نددوا بالإرهاب ولكنّهم في الوقت نفسه ندّدوا باستغلال ظاهرة الإرهاب لفرض الهيمنة الأمريكية على العالم وقتل الأبرياء، وهم الذين يميّزون تمييزاً واضحاً بين الإسلام ديناً وحضارةً، وبين الإسلام السياسي الذي تتخذه قوى متطرّفة ومتخلّفة فكرياً سبيلاً للوصول إلى السلطة، وهم يدركون جيِّداً أنّ الأقطار العربية والإسلامية هي الضحية الأولى لإرهاب المتطرفين، ويعرفون كذلك أنّ كثيراً من هذه الحركات قد موّلتها ودعّمتها مصالح الغرب نفسه.
إنّ الحوار المجدي الذي ينبغي أن تبادر إليه النُّخب في البلدان العربية والإسلامية يجب أن يتم مع هذه القوى، وأعني قوى المجتمع المدني في البلدان الغربية، فالحوار ضروري ولا بديل عنه لأنّ البديل الذي يطرحه الغُلاة من الجانبين يعني الدخول في صراع حضاري وديني وعرقي يؤدي في نهاية المطاف إلى الفوضى، وإلى مزيد من البلقنة والضعف والتخلّف في المنطقة العربية والإسلامية. وقد بدأت تلوح البوادر، وأخذ الإستراتيجيون العسكريون الأمريكان يتحدّثون عن الهدف الجديد بعد سقوط نظام طالبان.
إنّ مقولة (صراع الحضارات) مقولة أمريكية مؤدلجة وبدعة من بدع الفكر الصهيوني الشوفيني، ذلك أنّ دخول الغرب في صراع مع الإسلام والحضارة العربية الإسلامية، إنما يقدّم خدمة كبرى لسياسة إسرائيل ولأطماعها التوسعية في المنطقة، أمّا المقولة السليمة التي يجب أن تطرحها وتدافع عنها كلّ قوى السلام والتقدّم في جميع بلدان العالم فهي مقولة (حوار الحضارات)، ذلك أنّ الحضارات بطبيعتها متفتحة ومتأثّرة ومؤثّرة، ولم يعرف التاريخ حضارة منغلقة فالانغلاق معاد لطبيعة الحضارة.
لا بديل عن الحوار:
السؤال الجوهري والمحوري الذي يطرح نفسه في الساحة العربية، بادئ ذي بدء، هو: كيف نحاور! وحول ماذا؟ ومع مَن؟ لقد كَثُر الحديث بعد أحداث سبتمبر الماضي عن (الحوار)، ولقد عقدت الندوات العربية حول الموضوع، وأصبحت النُّخبة المثقفة العربية تتساءل: هل سيثمر الحوار حقّاً، وسيسمعه (الآخر) إذا ما قدّم بأسلوب الخطاب الرسمي العربي، ومَن يسبح باسمه آناء الليل، وأطراف النهار من (مثقفي) السلطة؟ وهل يمكن الحوار مع (الآخر) أصلاً إذا كان الحوار في جلّ الأقطار العربية مكبوتاً ومقموعاً؟ وقديماً قيل: فاقد الشيء لا يعطيه.
لنبدأ بالحوار بيننا، ولنتعوّد عليه في عقر دارنا، وأهم أنواع الحوار هو الحوار بين الماسكين بزمام السلطة وبين قوى المجتمع المدني، فالإنسان لا يستطيع أن يحاور الآخر حوار الند للند، وهو مرفوع الرأس إلّا إذا كان قادراً على الحوار بكلّ حرّية ودون خوف في بلده، ينبغي أن يقوم الحوار في الداخل حول قضايا مصيرية كبرى في مقدمتها مواطنون لا رعايا.
ومهما قويت العراقيل ضد الحوار، وحاولت قوى الردة والرداءة استغلاله فلابدّ لقوى التقدّم والحرّية والسلام في المجتمعين: الغربي والعربي الإسلامي معاً من الذود عن الحوار وقِيمه، والتصدي لأعدائها هنا وهناك.
إنّ رفض الحوار يعني بالنسبة للعالم العربي الإسلامي المزيد من التهميش والبلقنة، واشتعال نار الفتن العرقية، والمذهبية، والطائفية، فليس من الصدفة - إذن - أن تجنّد الصهيونية اليوم كلّ قواها، وبخاصّة في المجال الإعلامي لإقناع الشعوب الغربية بأنّ العرب والمسلمين منغلقون، ومتطرّفون، ويرفضون لغة الحوار مع الشعوب الأخرى، مستغلة في ذلك أعمال العنف التي تقوم بها جماعات متطرّفة هنا وهناك في العالم الإسلامي. فليس من الصدفة - إذن - أن يركّز الإعلام الصهيوني على إبراز نظرية (صدام الحضارات)، وهي نظرية شوفينية تلتقي مع جوهر الأيديولوجية الصهيونية التي تؤمن بأنّ الحضارة الوحيدة المتفوقة التي عرفها تاريخ المجتمع البشري هي الحضارة اليهودية التي بناها (شعب الله المختار) زاعمة أنّ الحضارة الغربية المسيحية هي البنت الشرعية للحضارة اليهودية.
في سبيل حوار حضاري:
برزت دعوة جديدة في مطلع الستينيات نادى أنصارها بالحوار بين الأديان، وخصوصاً بين الديانتين الأكثر انتشاراً: الإسلام والمسيحية، وجاء ذلك غداة انعقاد الجمع الفاتيكاني الثاني، وأصيبت الخطوات الأولى بالعرج والتعثر، فكان الفشل، والنتائج الهزيلة، ذلك أنّ بعض القوى المتنفذة داخل الكنيسة البابوية، ومَن يدور في فلكها من المسلمين السذج حاولت أن يكون الحوار دينياً لاهوتياً، فانكشفت النوايا منذ اللحظة الأولى.
إنّ الحوار الذي يخدم التفاهم بين الشعوب والاعتراف بالآخر سياسياً وثقافياً لا يمكن أن يكون إلّا حواراً حضارياً يتخذ من المقاربة التاريخية الثقافية منهجاً ونبراساً.
إنّ الحوار بين الإسلام والمسيحية، وهو الذي يشغل بالنا هنا، لا يمكن أن يثمر، ويتحوّل إلى ظاهرة فكرية وحضارية تشدّ إليها أنظار فئات اجتماعية متنوّعة في المجتمعين إلّا إذا توافرت الشروط الأساسية التالية:
أوّلاً - أن تقوم جميع الأطراف، وبكلّ موضوعية وجرأة بعملية نقد ذاتي، وأن تعترف بأخطاء الماضي، وأن تعمل بالخصوص على تصحيح الصورة المشوّهة التي روّجتها عن الآخر، وتقفز إلى الذهن هنا تلك الصورة السلبية والهجينة التي روّجتها الكنيسة الغربية عن الإسلام طوال القرون الوسطى، وقد برهنت اليوم دراسات المختصين الغربيين أنفسهم على أنّ تأثير تلك الصورة في الذهنية الأوروبية لا يزال مستمراً حتى اليوم.
إنّنا لا ننكر أنّ تياراً جريئاً بين المفكرين المسيحيين بدأ يعترف بأخطاء الماضي، فهذا المستشرق المسيحي لوي جاردي كتبَ يقول في هذا الصدد: "إنّنا جاهزون لنسيان الماضي، ولكن بأي وجه يمكن أن نطلب ذلك الموقف من الشعوب الإفريقية والآسيوية التي أُهينت بعمق، وذُلت كرامتها، وجرحنا مشاعرها القومية الدينية".
ولكن لابدّ من الاعتراف بأنّ هذا التيار لا يزال ضعيفاً، ولا يعبّر عن موقف الكنيسة الرسمي.
ثانياً - فصل الحوار عن السياسة، وإضفاء صبغة حضارية ثقافية محضة عليه، فقد أثبتت تجارب متعدّدة أنّ استغلال السياسة للحوار بين الأديان يُسيء إلى الحوار، ويعرقله، لا شك أنّ لهذا النوع من الحوار جانباً سياسياً لكن المهم ألا تستعمله سلطة سياسية قائمة لفائدتها اليوم، إنّه من المعروف أنّ السياسة استعملت الدِّين في كلّ العصور، وفي جميع المجتمعات، كما أنّ الدِّين قد استفاد من السياسة، ولكنّه قد آن الأوان لأن نفصل الدِّين عن السياسة.
ولما ننظر إلى هذه الإشكالية من زاوية الحوار الإسلامي المسيحي نلمس أنّ إستراتيجية الغرب نظرت إلى الإسلام منذ بداية مرحلة الاستعمار المباشر (القرن التاسع عشر) وحتى اليوم نظرة مزدوجة، فقد صوّر الإسلام، وبخاصّة نزوعه إلى الوحدة الإسلامية باعتباره تهديداً للمصالح الغربية، وبصفته تعصّباً معرقلاً (لرسالة أوروبا التحضرية) ذات الطابع الكوني، ورأت فيه من جهة أخرى (دين استقرار) يمكن استخدامه في إطار مبدأ (طاعة الحكّام) والمحافظة على النُّظم الصديقة.
إنّها إستراتيجية سياسية وضعت لحماية مصالح الغرب، وقد اقتضت هذه المصالح أن تكون هذه النظرة إلى الإسلام مزدوجة، وهي إستراتيجية لم تتغير اليوم كثيراً في تحليلها للأوضاع في المجتمع الإسلامي، ولكن المهم أن نعي في هذا الصدد أنّ الكنيسة الغربية باركت بالأمس، وتبارك اليوم هذه الإستراتيجية، ذلك أنّها تخدم في نهاية المطاف مصالح المركزية الغربية توأم المركزية المسيحية.
أصبح دُعاة الحوار الإسلامي المسيحي يرددون في الأعوام الأخيرة مقولة العالم اللاهوتي الألماني هانس يونج: "لن يكون هناك سلام بين الأُمّم، ما لم يكن هناك سلام بين الأديان، ولن يكون هناك سلام بين الأديان، ما لم يكن هناك حوار بين الأديان".
إنّها مقولة نبيلة، دون ريب، ولكنّها مثالية، فإذا أردنا أن يُثمر الحوار بين الأديان يوماً ما، فلابدّ أن تكون الخطوة الأولى هي فصل الدِّين عن السياسة، ونقول: لن يكون هناك سلام بين الشعوب، وسلام بين الأديان إلّا إذا كان الحوار سياسياً حضارياً بعيداً عن فخ الحوار الديني اللاهوتي.
الكونية والخصوصية الثقافية:
إنّ خطاب عدد من المفكرين العرب يقع في فخ الخطاب الرسمي العربي، فهو غارق إلى الأذقان في العولمة سياسياً واقتصادياً، ويتحدّث عن الخصوصية الثقافية ليس لأسباب ثقافية، بل لأسباب سياسية، حتى تصبح الصيغ الخاصّة المشوّهة للديمقراطية من الخصوصية الثقافية، وكذلك مفهوم حقوق الإنسان، وحتى يتحوّل الجام وسائل الإعلام، وتشديد الخناق على حرّية الإبداع ذوداً عن قيم الخصوصية الحضارية، ولا نستغرب أن نسمع مَن يزعم غداً أنّ حرمان المرأة العربية من حقوقها، والحكم عليها بقبول أوضاع التخلّف والاضطهاد أمر مرتبط بقيم الخصوصية الحضارية.
لابدّ من الاعتراف الشجاع بأنّ معالم الهُويّة الوطنية قد اهتزّت، بل تصدّعت أركانها أمام موجة الثقافة المعولمة.
إنّنا نقر بأنّ الحديث عن العولمة الثقافية يجرّ حتماً إلى إثارة إشكالية الجدل بين الكونية والخصوصية، وهنا تتباين الآراء، وتسيطر على هذا الجدل في المستوى العربي للأيديولوجية، أو البقية الباقية منها، وتتحوّل الخصوصية إلى قميص عثمان، المدافعون عن الخصوصية يمثّلون تيارين مختلفين سياسياً وأيديولوجيا، تيار الوطنية الضيّقة، وتضخيم الذات، والتغني بهُويّة الماضي، وإن تحوّلت اليوم إلى فولكلور رديء وممجوج، وتيار تراثوي ماضوي، ورغم اختلاف التيارين أيديولوجياً، فإنّ أنصارهما يصبّون الزيت على نار واحدة، نار الشوفينية والأصولية، وهو منطق معادٍ للحوار.
السؤال المحوري الذي ينبغي أن يُطرح في هذا الصدد هو: هل العولمة الثقافية هي مرحلة تاريخية تنصهر فيها الثقافات المحلية والوطنية في ثقافة كونية تفيد من الجوانب المضيئة في قِيم تلك الثقافات وتعمل على نشرها، والتعريف بها عبر وسائلها المؤثرة، أم هي (غزو) واختراق يجب التصدي له بكلّ الوسائل، وإن بلغ الأمر حدّ العنف، كما تؤمن بذلك جميع النزعات الأصولية سواء كانت ذات طابع وطني، أو قومي شوفيني، أو ذات طابع عرقي أو ديني.
إنّ عملية التثاقف والانصهار في الثقافة الكونية تتم ضمن صيرورة جدلية معقدة، ولكن الانصهار يمثل كسباً ثميناً للثقافات من جهة أخرى، وينبغي ألا نخلط بين ما تقدّمه العولمة الثقافية من مكاسب لتقدّم البشرية وبين استغلالها سياسياً من طرف القوى الدولية المهيمنة اليوم.
إنّنا لا ننكر أنّ للعولمة الثقافية جوانب سلبية بالنسبة لثقافات الشعوب المتخلّفة اقتصادياً وتقنياً، ولكن مقاومة هذه الجوانب السلبية يجب أن تتم ضمن معركة داخلية تخوضها شعوب الأطراف، وبينها الشعوب العربية ضد الظلم والاستبداد والرداءة السياسية والثقافية، ومن أجل الحرّيات العامّة، والديمقراطية والإبداع، فكيف تستطيع أن تسهم في عملية التثاقف العالمي، وتعبّر عن خصوصيتها الحضارية ضمن صيرورة العولمة الثقافية إذا كانت تئن تحت نير الاستبداد السياسي، وما يفرزه بالضرورة من رداءة ثقافية؟
المعركة الحقيقية التي ينبغي أن تسخّر لها جهودها النُّخب السياسية والفكرية، وجميع قوى المجتمع المدني هي معركة داخلية من أجل الديمقراطية، ومواجهة اغتصاب السلطة في كثير من الأقطار العربية لحقوق المواطن، أمّا التصدي لـ(الاغتصاب الثقافي) بالشعارات الجوفاء، فهي معارك وهمية خاسرة تلهي الشعوب عن معركتها الحقيقية وتزيد في تهميشها، وتبعدها عن منطق الحوار من أجل السلام والتقدّم.►
المصدر: مجلة العربي العدد 524/ لسنة 2002م.
مقالات ذات صلة
ارسال التعليق